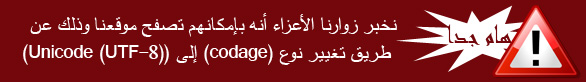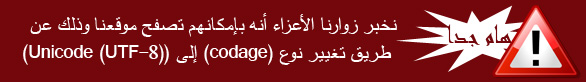لماذا قررت الدخول من “بوابة جهنم” إلى كتاب الشاعرة والناقدة المصرية فاطمة ناعوت، الموسوم ب “الكتابة بالطباشير.. مقالات في الفن والأدب”، والصادر عن دار شرقيات. هذا الكتاب مستفز.. يواجهك مباشرة بالأسئلة التي تقوم في رأسك كلما كان الكتاب جيدا، والمكتوب مربك، وموخز.. إذ ليس الشك وحده هو الذي يقود إلى اليقين بالضرورة.. بل الوخز والإرباك أيضا.. و الفضول أحيانا.
ما يراوغ في هذا الكتاب ليس العنوان.. و لا المضمون. فذاك يحتاج منا إلى إطلالة ستأتي. لكننا لا يمكننا تجاوز الإهداء بحال من الأحوال.. والذي نقرأ فيه أن هذه الشاعرة تهدي كتابها “إلى الشعر” الذي سمح لها باستعمال الطباشير للكتابة “على هامشه”. فهل يمكننا التسليم بأن كتابا كهذا جاء على هامش الشعر الذي تكتبه الشاعرة فاطمة ناعوت؟ أم أن الإهداء بعد العنوان جاء في سياق رسم معماري هندسي ما بعد حداثي، مثير للأسئلة هو الآخر، مثل ذلك الباب المرسوم بعناية على ظهر الغلاف الخارجي للكتاب.. باب في الصحراء.. وإهداء مراوغ يشبه إلى حد كبير بوابة جهنم التي طلب منهم أستاذ الرسم الهندسي رسمها و تخيلها، مستعملا ذلك المدخل الذكي كأول خطوة لشرح مفهوم “ما بعد الحداثة” أو تقريبه من أذهان طلبته.
و من هنا فقد قررت و من البداية الولوج من هذه البوابة، رافضا التسليم بأن هذه الكتابة جاءت على هامش الشعر، لأنني أراها مرافقة ومجاورة وموازية للعملية الإبداعية.. وفي الموازاة تختلط طبعا مفاهيم المتن والهامش، لأنها بكل بساطة ترجع للزاوية التي يحبذها القارئ. وتخضع لمبدأ الرغبة principal of desire ف” ليس كل ما هو صلب يذوب في الهواء”.
ولأن رحلة البحث عن أجوبة بدأت منذ أول سؤال طرحه آدم على نفسه لحظة تصادمه مع عالم جديد، فإن “الكتابة بالطباشير” تتماهى مع رحلة أزلية كهذه، لتهدم، و تعيد البناء، ثم تهدم ما بنته لتهدمه من جديد، لتنقل لنا قلق الكاتبة في عصرها، الذي بالضرورة يختزن قلقا آخر لعصور مضت و يستشرف قلقا قادما استثمرت فيه الكاتبة والشاعرة كل معارفها الهندسية لتتساءل مجددا مع ابن عربي: ما الذي يملأ الكون؟ إنه السفر..
و هنا أؤيد الأستاذ الكبير محمود أمين العالم الذي قدم لهذا الكتاب، حين وصف هذه الكتابة بأنها “وفي غير مغالاة كتابة بالحفر العميق في حقائق و ظواهر تجاربنا الثقافية القومية والإنسانية” ص9 . و أخالفه حين حذر القارئ من الاغترار بالعنوان معتبرا أن ما يكتب بالطباشير يمحى، لأؤكد أن ما يكتب بالطباشير هو الذي لا يمحى. فهل محونا اللوح في الكتاب قديما لننساه أم لأنه أخذ طريقه للخلود إلى عالم النسيان. إنه لا يمحى لأنه ينتقل إلى مرتبة أخرى.. و هنا مراوغة الشاعرة الجريئة التي جعلتني أتذكر الشاعر المغربي الكبير محمد بنيس صاحب “كتابة المحو”.
ويظهر تفنن الشاعرة في الكتابة بطباشيرها في الترتيب الذي اعتمدته لمقالات الكتابة، مقدمة الفكرة على زمن الكتابة، فالترتيب يخضع لأولوية الحضور المفاهيمي بعيدا عن مكان المداخلة أو زمانها، ولعل ما شدني حقا هو ذلك الفرش للكتاب كأنه التحذير الضمني من الكاتبة “احذر أيها القارئ فأنت أمام مفاهيمية جديدة لكتابة مختلفة”، وليسمح لي القارئ هنا باستعمال مصطلح “اخ (ت) لاف” كما قرره جاك دريدا بوضع التاء بين قوسين مثلما استعملها الشاعر كاظم جهاد مترجم كتاب: “الكتابة والاختلاف” – مصطلح الاختلاف لدى جاك دريدا ” مشيرا لمصطلح Differance مستبدلا حرف e بحرف a.
فما أروعه مفتتح مربك حول أسئلة “الاخ (ت) لاف” و ما بعد الحداثة مثل: هل استنفدت الحداثة شروط وجودها؟ ما هو أول ظهور زمني ل”ما بعد الحداثة”؟ وفي أي فن ظهرت؟ هل حدث ذلك في الأدب؟ أم في العمارة؟ أم في غيرهما من الفنون الأخرى؟ لتؤكد الكاتبة في معرض البحث عن أجوبة ممكنة أن سنة 1934 علامة ميلاد وظهور، وأن هذا التاريخ سيظل مرتبطا بنشأة ما بعد الحداثة في حقل النقد الأدبي على يد الناقد فيدريكو دي أونيس في كتابه “أنتولوجيا الشعر الاسباني-الاسباني و الاسباني-الأمريكي”، لينتهج نهجا “ينفي الحداثة و يعلن رفضه لكل أسها ومبادئها..” ص14. فإذا كانت “..الحداثة تحترم المتن فإن ما بعد الحداثة تولي عين التبجيل للهامش..” ص 14 متخذة من “.. التشظي سمة أساس” ص 21 في فكرها، و الذي يتجلى في الأدب في “سقوط الجدر الفاصلة بين الأجناس الأدبية و الفنية” و في العمارة في مثل مبنى (سوني) الذي صممه المهندس فيليب جونسون في مدينة نيويورك. إنه موت ل (Logos) لمبدأ العقلاني في الكون.. وظهور لثقافة أخرى مكتنزة ب “الأساليب غير المترابطة و الحنين غير المنظم للماضي..” ص 14. وقد تطرقت الكاتبة لإشكاليات مماثلة لهذه الإشكالية في مقالات أخرى من هذا الكتاب الذي يحوي 19 مقالا (صدفة أو عمدا) مثل مقالة “الشعر و العمارة” في الصفحات بين 53 و 56 لتقرر من جديد بأن “الكاتب يسعى دائما في كل عمل إبداعي إلى استخلاص نقاط النور من العتمة، ورصد البقع السوداء داخل الثلج..” ص 54، كما نجد زاوية أخرى للنظر في موضوعات الشعر في مقال “الشعر والحرب” في الصفحات بين 109 و 115.
وفي “مرآة ابن رشد” تتخذ الشاعرة فاطمة ناعوت من قصة بورخيس الشهيرة “البحث عن ابن رشد” مدخلا “للولوج داخل الجوهر العميق لمفهوم فعل (الترجمة)؟ ص 30″، بوصفها عملية إشعاع مركزي لروح ونسغ حضارة قطعت شوطا في مسار البشرية في اتجاه ما، إلى شعوب أخرى لم تصل إلى نقطة الضوء ذاتها” ص 30، مؤكدة أن الاشكال في المضمون لا في الشكل، في الروح لا في الجسد، في العمق الحقيقي الذي يجب استجلاؤه، إنها ترجمة الدلالة العميقة، لا اللفظة التي تحمل في جوانبها عوائق وعلائق لابد من التخلص منها، و بالتالي فإشكالية الترجمة كفعل، تتطلب أدوات شتى وعملا دؤوبا مستمرا لا ينتهي عند النقل والتغيير من شكل إلى شكل بل منه يبتدئ، معززة ذلك بما قاله الشاعر الكبير جلال الدين الرومي “اذهب، واسع وراء المعنى، يا عابد الصورة!” ص 31
ولم تنس الكاتبة التدليل على فضل الترجمة على الإنسانية من خلال تقديم “ابن رشد” و مجهوداته ك “شارح” لفلسفة أرسطو مثالا على هذا الفضل، ملخصة أنه لولا الترجمة ما عرف العرب أسلافهم كابن رشد من خلال الغرب، ولما عرف الغرب أسلافهم كأرسطو من خلال العرب، مقررة أن أزمة العرب في الترجمة من خلال مبدإ مجتمع المعرفة تكمن في “اللحاق أو الانسحاق” ص 34، راجية أن نتمكن من الاستفاقة من غفوتنا كي لا يكون مصيرنا “مثل طائر أمل دنقل حين قال: سكين الذبح هي مصير الطيور التي حطت من السماء إلى الأرض..” ص 37
أما في مقالتها “تفاحة يكاسو” فإن الكاتبة تتحدث عن أبعاد أخرى مشيرة إلى أن المدرسة التكعيبية في الفن ركزت على بعد جديد هو الزمن كبعد رابع، في حين حاولت المستقبلية إضفاء بعد آخر لم تعن به التكعيبية ألا وهو “الحركة”، بينما نجد أن كلا البعدين قد اكتشفهما الفنان الفرعوني القديم وسبق جميع المدارس الحديثة، و ذلك مثلما في لوحة كليوباترا، مسهبة الحديث في مقالها “العمارة والشعر” عن علاقة العلم بالفن، تلك العلاقة التي تراها الكاتبة “وثيقة، بل وشيجة مشتجرة، خيوطها لا تنفصم..” ص 42، بل إن روعة الامتزاج هي التي– تقول الكاتبة– “تبهرني كمتلقية للعمل الأدبي والتي تغريني بالخوض فيها كشاعرة..” ص 42
“لأن الفتاة كانت أكثر إيمانا بأحلامها، فقد أمطرت السماء” ص 46.. ربما هذه هي العبارة التي يمكن أن تلخص كل شيء وأي شيء في مقالة “الباليرينا الخلاسية تهزم الموت بالرقص”. وقبل أن أصل مع الكاتبة إلى تلك الجملة/ النتيجة، كنت قد عبرت محطات ومحطات، رابطا في القراءة بين رواية كويلو “فيرونيكا تقرر أن تموت” و الفيلم المصري “انت عمري” و أحداثه التي تحدثت عنها الكاتبة والتي تدور حول فتى و فتاة يتحديان الموت.. وبين رواية “سيدة المقام “لواسيني الأعرج، و التي تأتي بتحد آخر من فتاة راقصة باليه تقرر أن ترقص برصاصة في الدماغ، و هو ما حذرها منه الأطباء، لأنه يعني الموت.. إنه الرقص في مواجهة الموت. و ها هي الكاتبة تجزم أن “عدم الإيمان بأن الحياة أحيانا تحب أن تخادع قانون الاحتمالات من أجل كسر منظومة التوقع ومنطق الأمور فقط كي تبقي على دهشتها الدائمة لنا..” ص 45
لكن هل يمكن طرق كل هذه المشكلات دون التعرض إلى تحد جوهري بالنسبة لثقافتنا العربية، بعد أن تمكنت الثقافة الغربية من تجاوز الكثير من علائقها؟ تلكم هي مسألة “كتابة المرأة” بكل أبعادها الخمسة على رأي الفنان الفرعوني، هذا التعبير الذي صار يعرف بالكتابة النسوية، وتكر له الندوات والملتقيات و الإصدارات، وهي بالنسبة لي طريقة خاطئة، تكرس المفهوم الخاطئ أكثر مما تعالجه، لأنه الأجدر بنا الاحتفاء بالمواضيع و المضامين بغض النظر عن جنس الكاتب، لأن في هذه التفرقة يكمن الخطأ، و هو أمر تساهم فيه المرأة نفسها، حين تقبل الطرح، و تزكيه وتشارك فيه، و قد تحدثت الكاتبة عن جوهر هذه الفكرة، في مقالتيها “كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه”، و “صعوبة أن تختصر في حذاء” مؤكدة أن المرأة “بيدها لا بيد عمرو– كرست في كثير من الأوقات أسباب تغييبها..” ص 48، مضيفة أنه “من أسباب انهيار الثقافة العربية طوال الوقت كونها تسير بخطى عرجاء على ساق واحدة– الرجل– في ظل غياب تام للمرأة..” ص 49، لتشير إلى أن المرأة في الغرب لم تصل إلى مكانتها إلا بعد معاناة و تحديات واجهتها وتغلبت عليها.. متخذة من الكاتبة فرجيينيا وولف مثالا على ذلك، وخاصة في مقالتيها في كتاب “غرفة تخص المرء” وفي مقالة “ثلاث جنيهات”، لفتح قوس هنا وهو أن للكاتبة فاطمة ناعوت كتابا كانلا خصته لهذه الكاتبة و المرأة المميزة بعنوان “جيوب مثقلة بالحجارة” و قد لخصت المر كله أبرع تلخيص قائلة، “فلو نجحت المرأة في رؤية نفسها كإنسان.. إنسان فحسب..” ص 49 لتجاوزنا هذا العرج.. و هذا الداء الفكري الذي ما يزال ينهك مسيرتنا.
على عكس ما تبادر للكثيرين من خلال عنوان كتاب الكاتب المصري شريف الشوباشي المراوغ “لتحيا اللغة العربية، ويسقط سيبويه” فإن الكاتبة تحرص على تبيين الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، مبينة “أن الدافع الوحيد الذي حث المؤلف على الكتابة هو دافع قومي عروبي وغيرة على العربية وحزن على غيابها من خارطة اللغات المعترف بها عالميا..” ص 62، وقد حاولت في تمفصلات هذا المقال، وتجليات هذا الكتاب أن توخز الذهنية العربية “الجامدة” بما استطاعت من عبارات، للتحسيس بالهوة الواسعة بين “خطابنا والخطاب الغربي نتيجة اعتيادنا تضخيم الكلم والركون إلى امتلاك اليقين..” ص 63 ، و لكي لا تكون كمن “ينهى عن خلق ويأتي مثله” على رأي الشاعر القديم، فإنها بينت أن الكتاب قد خلط نوعين من الخطاب: الخطاب الأدبي البلاغي، و الخطاب الحياتي الإبلاغي.. فالأول “يندرج تحت باب الفن..” كونه ” انحراف عن الواقع تصنعه طاقة في روح الفنان وفي عينيه تتوق إلى إعادة تشكيل العالم” ص 63، أما الثاني ف “هدفه الإيصال والإبلاغ ” ص 63، ولا يمكنه أن يخلو من “المجاز” وقد عضدت الكاتبة رأيها في ذلك بكتاب “المجازات التي بها نحيا” لأستاذين أمريكيين، خاتمة مقالها هذا بتهنئة لصاحب الكتاب وبتساؤل مفجع “لماذا نطالب اللغة أن تحني هامتها من أجلنا، لماذا لا نحاول نحن أن نعلو قليلا”. ص 64
ولم تخرج الكاتبة عن موضوع اللغة واللحن فيها في مقالها الموالي “سيبك م النحو.. بس ايه رايك في القصيدة”، مشرحة أزمة العربية وغربتها بين أبنائها، وكتابها، وشعرائها، وصحفييها، لتشير كمثال على ذلك إلى الهرم الإعلامي جريدة “الأهرام” التي بدأ يدب إليها التداعي لعدة أسباب لخصتها الكاتبة، داعية إلى ضرورة العودة إلى الأمجاد السالفة، وذلك بتفادي هذه الهنات اللغوية التي تحيل على استفهامات كبرى؟ استفهامات تنسحب على قطاعات أخرى.. وذلك أن الأجيال القادمة لن تغفر، وقد أوردت الشاعرة فاطمة ناعوت في هذا المقام عبارة الشاعر ت. س. إليوت “بعد كل هذه المعرفة، أي غفران؟!” ص 67. و”انطلاقا من فكرة أن البناء هو الهدف النهائي لكافة النشاطات الإبداعية بتعبير جروبيوس” ص 69، راحت الكاتبة تتحدث في مقالها (نظرية التشكيل عند بول كلي)، عن مسيرة الأستاذ عادل السيوي الإبداعية، الذي عرف العملية الإبداعية في كل مراحلها وأبعادها، والذي ترجم كتاب نظرية التشكيل لبول كلي متحدثة عن الباوهاوس الذي ساهم “في تكريس و شرح مفهوم الحداثة في التشكيل باعتبارها تجربة ذات محاور ثلاثة: الوظيفية، الحيادية، ومحاولة اكتشاف القوانين الكبرى للكون” ص 70. وقد ثمنت الكاتبة جهود المترجم والمبدع السيوي وخاصة أن هذا الكتاب يحفل” بالعديد من المحاور الفلسفية والعلمية التي تعالج نظرية التشكيل وكيفية تكون دلالات الشكل داخل العقل البشري..” ص 71
وقد استمرت الكاتبة في تقديم أفكار مختلفة ومبهرة، خاصة عندما تطرقت لموضوع الترجمة في مقالها “ترجمة الشعر.. فعل إبداع”، حيث تشبه الترجمة ب “خطيئة بروميثيوس النبيلة، حين رق شعلة النار من السماء..” ص 73، معتبرة المترجم بأنه “ذلك الفنان الذي يؤرقه ولع الكشف والتنقيب عن النفائس” ص 74، وقد قسمت مقالها هذا إلى محطات منهجية لا يدركها إلا من يمعن القراءة، حيث ابتدأت بالحديث عن الترجمة الحرفية باعتبارها “ايغال في الخيانة” قائلة مع “البروفيسور بارنستون: A Translation is an X-ray , not a Xerox” ص 75. وقد اعتبرت في المحطة التالية أن الانتقال عبر المنظومات اللغوية هو أصعب ما تلقاه ترجمة الشعر، داعية مثلا إلى محو مصطلح “الشعر الجاهلي” من ذاكرتنا العربية”، كونه حكم قيمي ينتمي إلى تقسيم ديني بعيدا عن التقسيم الجمالي للشعر” ص 76، إذ أنه ومن خلال تجربة تسردها الكاتبة هنا، حيث كانت تقوم بمراجعة كتاب مترجم من العربية إلى الإنجليزية وهو كتاب (الرهان على المعرفة) و جدت أن أحد المترجمين ترجم “عبارة” الشعر الجاهلي” ب Rogue Poetry بما يعني “شعر المشردين أو الأوغاد أو الجهلاء” ص 76، وقد اقترحت الكاتبة في هذا السياق “نقل عبارة “الشعر الجاهلي “بالدلالة الزمانية أو الوصفية أي شعر ما قبل الإسلام Pre-Islamic Poetry أو شعر الوثنيين Pagans’ Poetry ” ص 76. وبين سطور هذا المقال الذي يعكس عمق ثقافة الكاتبة ورصانتها، نلم آراء أخرى، جريئة ومغايرة، حيث تتحدث عن الترجمة الحرفية من عدمها في فقرة (الدلالة والطاقة وليس المعنى)، معتبرة أن “الاعتداء على حرم الفن ومباغتة حصونه متعة..” ص 77، لا يدركها إلا من “ذاق شراب القوم “على رأي المتصوفة” فلا باس إذن من شيء من المكر وبعض الاجتراءات الشريرة، ولكنها اللعبة الخطرة التي يجب أن تنطوي على مهارة فائقة ووعي بالأدوات”. ص 77
وبعد الإشارة إلى ما عناه الصينيون بمنهج “الرقص داخل الأغلال”، انتقلت الكاتبة لتبرز رأيها المختلف في فقرة (السفر عبر الألسن)، الذي عدته وسطا بين التعريف الذي يتبنى من خلاله “فراي لوي دي ليون” ترجمة الشعر، والمفهوم concept الذي يتبناه د. محمد برادة. فلا هي تؤيد “الامتصاص الكامل للقصيدة” ص 78، ولا هي مع “تهشم اللغة المنقول إليها..” ص 78، ولا بأس بوجود بعض الوخزات التي “من شأنها إنعاش ركود اللغة وإعمال الحس التشكيلي لدى القارئ” ص 79. وهنا وبمنهجية فذة تفتح قوسا لتتحدث عن “طاقة الكلمة” بتعبير العقاد.. إذ على المترجم أن يبرز مواهبه في استنطاق “المسكوت عنه داخل النص” ص 79، وأن يبحث “عن مغايرات دلالية تستنطق أبجديات اللغة لحل المسألة” ص 79. لكن من هو هذا المترجم الذي يقوم بكل هذا؟ تقول الكاتبة مجيبة على هذا السؤال ومعرفة المترجم بأنه “من يمتلك حسا أدبيا، و ذا أمانة مع قدرة على الابتكار والتخيل” ص 80. إذ يكمن “الفردوس” في “لحظة الترجمة ذاتها” ص 80، ذاك ما تؤكده في فقرة (لحظة استحضار الشعر) لتخلص إلى أن “الشعر لا يترجمه إلا شاعر” ص 80، وهذا صواب كبير. فالذي لا يعرف الشعر و الشعراء لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يقيم صداقة معهم، (صداقة متخيلة بتعبير بارنستون). ثم تقرر الكاتبة بعد ذلك وفي فقرة أخرى بعنوان (الأصالة و الاستقلال) صعوبة التحديد بين إن كان النص المترجم، نصا فريدا.. بحكم “أن الترجمة تتوق للاستقلال..” ص 81 “أو نصا تابعا فقط للنص السيد” الأصل، “مستأنسة بما قاله أوكتافيو باث” كل نص هو نص فريد، و في الوقت نفسه هو ترجمة لنص آخر..” ص 81
إنها استفهامات جادة، يطرحها كل من دنا من عالم الترجمة أو الكتابة الإبداعية، بل يطرحها القارئ الحصيف عادة.. حيث تستمر الكاتبة في هذه المقالة المميزة في تفكيك المفاهيم وتقريبها، لتبدي رأيها بعد ذلك، مستأنسة بما استقرت إليه إلى حين كتابة هذا المقال.. فواصل ومحطات مثل “اللغة تحور نفسها وتعيد خلق ذاتها بشكل مستمر” ص 82، ف “حري بنا أن نتقبل هذا التحول كلعبة تؤكد أننا ما زلنا نحيا، لعبة تدعو للبهجة لا التحسر” ص 82، مضيفة أنه على القارئ أن ينتبه أنه “لا يقرأ الأصل عينه بل يراه عبر حواجز أفقية (جغرافية) وحواجز رأسية (زمنية)” ص 82. وهنا يتسرب سؤال الدقة، مما يجعل القارئ طرفا مهما حين يستثيره هذا النص المترجم ويثير “مكامن المكر” في داخله. وهذا ما كان يحدث للشاعرة/الكاتبة فاطمة ناعوت حين تبحر في نص مترجم. وهاهي تستشهد “بأكثر المشاهد شهرة في الأدب الكلاسيكي القديم وهو اللقاء الشهير الذي تم بين هكتور وزوجته في الكتاب السادس من إلياذة هوميروس” ص 83، لتقارن وتحدد زاوية رؤية مغايرة لهذه المعادلة الصعبة المثيرة للقارئ الواعي، الأصل الإغريقي واحد، “والتباينات لافتة في طرائق النقل من اليونانية إلى الانجليزية” ص 85، وقد اختارت الكاتبة هذا المثال “لأنه يحمل معنى التباين الأفقي (الجغرافي) بين منظومات اللغات واللهجات المختلفة من ناحية، وأيضا التباينات الرأسية (الزمني) حيث تراوحت الترجمات بين بدايات القرن 16 وحتى نهاية القرن 20″ ص 86. هكذا بينت الكاتبة عدة زوايا لهذه الإشكالية الشائكة، وقربت للقارئ مفاهيم كانت مستعصية ومحلقة في فضاءات اللافهم والغموض.. لتقرر في نهاية مقالها أن “المترجم خزاف مبدع يصوغ روح الطين القديم ويعيد خلقه في منتج فني”. ص 87
مرة أخرى تفرد فاطمة ناعوت زاوية الحديث عن حرية الكتابة خاصة، والإبداع بصفة عامة كذلك في مقالها “ريشة دافينشي وثقافة كاتمة للصوت”، من خلال حديثها عن كتاب حلمي سالم “ثقافة كاتم الصوت” الصادر عام 2003.. والذي اعتبر فيه كاتبه أن القرن العشرين هو قرن المصادرات، “إن عقدا واحدا في القرن العشرين لم يخل من مصادرة” ص 90، ولعل من أروع ما في المقال هو تلك الكلمات التي استهلت بها الكاتبة والتي تضعنا وجها لوجه أمام واقع مروع، “أنشغل بالدفاع عن قيثارتي، أكثر مما أعزف ألحاني” ص 89، هكذا تألم عبد الرحمان الخميسي بينما تألم صاحب (النداهة) يوسف إدريس بقوله “إن الحريات التي تمنح لكل الكتاب العرب مجتمعة لا تكفي مبدعا واحدا ليكتب” ص 89، ونعود لحلمي سالم الذي خلص في كتابه إلى حقيقة مرة وتعجب مرير “كأن حكومات الاستعمار والرأسمالية والإقطاع كانت أرفق بالمبدعين والمفكرين وأقل تعنتا إزاء حرية الرأي من حكوماتنا الوطنية التحريرية!” ص 90، ليحلل بعدها مفهوم التطرف محددا أنواعه، ومن بين تلك الأنواع نوع أشد خطورة هو “إرهاب النخبة المثقفة” والذي عرّفه بأنه “على نحو يعني أن جرثومة احتكار الصواب المطلق لا تعشش في ثنايا السلطة السياسية العربية ولا في طوايا الإسلام السياسي المتطرف فحسب، بل هي كامنة في حنايا المثقفين” ص 90، وقد حلل لكاتب أيضا ثورة يوليو 52 تحليلا سياسيا واجتماعيا “راصدا الأسباب وراء فشلها في طرح نظرية اجتماعية / إيديولوجية/ سياسية واضحة المعالم” ص 91، متحدثا عن سلبيات الثورة التي “لم تنشأ جميعها من داخلها” ص 91، مشيرا إلى بعض إيجابياتها مثل “إنشاء أول وزارة للثقافة في مصر عام 1958″ ص 92، ويختتم “بعرض شهادتين توثيقيتين هامتين، إحداهما تجسد أزمة جيل الخمسينيات الذي كُسر حلمه في حزيران المرير وهي قصيدة (مرثية العمر الجميل) التي كتبها أحمد عبد المعطي حجازي، والثانية شهادة المؤرخ و الصحافي صلاح عيسى في كتابه (مثقفون وعسكر)..” ص 92، ثم يعرج إلى مناقشة (المعاصرة المؤصلة) كما سماها عادل حسين في كتابه (نحو فكر عربي جديد) كما يقدم قراءة نقدية لكتاب برهان غليون (اغتيال العقل)، وأعاد طرح أسئلة واستفهامات د. لويس عوض التي طرحها في كتابه (مقدمة في فقه اللغة العربية) الذي تمت مصادرته بعد ظهوره في مصر عام 1980، ويتحدث أيضا عن قضيتي علاء حامد وسعيد العشماوي”، مقارنا بين محاكم التفتيش الكنسية في العصر الوسيط في أوربا في القرن ال17 قبل الرينيسانس، وبين الأزهر كقلعة علم و تنوير في القرن ال 21″ ص 93. كما أثار كتاب حلمي سالم حسب مقالة الكاتبة فاطمة ناعوت قضية اغتيال الكاريكاتوري ناجي العلي واغتيال المفكر فرج فودة مؤكدا “أن المصادرة الوحيدة التي لم تتم وأحرى بها أن ترى النور هي (مصادرة المصادرة)”. ص 93
في هذا السياق، ذات الفعل/المصادرة يأتي مقال “محنة الوصايا”، وتقصد بالوصايا ديوان الشاعر أحمد الشهاوي (الوصايا في عشق النساء) الذي تمت مصادرته بتوصية من الأزهر عام 2003، حيث تشير أن “الكاتب العربي منذور دوما لخوض ساحتي رهان لا واحدة مثل كل مبدعي العالم..” ص 94، والساحتان هما الاجتهاد في الإبداع، والاجتهاد في “ألا يخرق قلمه (المبدع العربي) سقف المسموح الديني أو السلطوي..” ص 94، وقد أشارت الكاتبة إلى محنة الشاعر السعودي علي الدميني والروايات المصادرة، ومحاولة اغتيال الراحل نجيب محفوظ، واغتيال فرج فودة، مقارنة ذلك بما كانت تفرضه الكنيسة من سلطة على الحريات والأفكار مثلما حدث مع جاليليو ومن بعده ديكارت الذي أحجم عن طبع كتابه (العالم) مخافة بطشها، داعية الأزهر أن يخلي بين المبدع والسماء لأن أداة حياة الكاتب الوحيد” هي فقط هذا الخيال الموؤود..” ص 96
أما في مقالها “النسوية والمواطنة” فإن الكاتبة تعرض كتاب الناشطة النسوية النيوزيلندية (ريان فوت)، المترجم من طرف كل من أيمن بكر وسمر الشيشكلي، والذي راجعته الحقوقية فريدة النقاش، حيث أن (فوت) بعد أن انطلقت من تعريف أرسطو للمواطنة و”المواطنة الفعالة كمفهوم إجرائي خاص بأرسطو، تعمق لرؤية بأن تتساءل عن هذه الأحادية (الرجال) وعن موقع النساء الذي يفترض مساواة إذا ما أردنا معادلة صحيحة، معتبرة أن النساء في الغرب ما يزلن مواطنات من الدرجة الثانية، لتتعجب فاطمة ناعوت متسائلة عن الدرجة التي يمكن أن تكون فيها نساء العالم الثالث! لكن فريدة النقاش مراجعة الكتاب تأخذ على (فوت) “إغفالها تناول مفهوم الطبقية كأداة تحليل لقضية المواطنة”. ص 98. كما لم تنس الكاتبة إبداء رأيها في كتاب (الإسلام دين وأمة، وليس دينا و دولة) للمفكر الإسلامي جمال البنا الأخ الأصغر لمؤسس الإخوان حسن البنا، وذلك في مقالها “سهم السلطة في كعب العقيدة”، معتبرة أن السلطة ما دخلت في شيء إلا أفسدته مستقرأة تاريخ الشرق والغرب مقترحة لو تصبح “أفكار هذا الكتاب مدارا لحوار عام يستطلع أراء كافة العقول” ص 104، كونها أفكار تهم حاضر الأمة العربية والمسلمة ومستقبلها.
أما مقالها (”الآخر” وقصيدة النثر المصرية) فإننا نلجه من فقرته الأخيرة، “إن المناداة بقيام مجتمع مدني فعلي في مصر والبلاد العربية وانتهاج سوسيولوجيا لتعدد وعدم نفي الآخر، لم يعد ترفا بوصفه حلما بعيد المنال لكنه ضرورة حياة” ص 108، وكذلك قصيدة النثر حيث تقول الكاتبة أننا تأخرنا كثيرا بل ربما أزيد من قرن من الزمن في إعطائها فرصتها، فيجب أن نتخلص من عوائق ذهنية سلفية صمدت أمام أعظم النظريات كنظرية النسبية لأينشتاين. إن كل حجج السلفيين واهية فليتركوا الشمس تشرق على الجميع.
أما في محطتها الموالية “كيف لم نضع حدا لهذا؟”، فإنها تشير إلى أن يوم الشعر العالمي 12 فبراير أصبح يوما للاحتجاج في أمريكا بعد أن رفض الشاعر سام هاميل دعوة البيت الأبيض عام 2003. وقام بإرسال رسالة إلى شعراء أمريكا ثم العالم كي يحتجوا ضد هجمة (الصدمة والرعب) في العراق لا بتوقيعاتهم بل بقصائدهم التي أصدرها في (انطولوجيا الاحتجاج Anthology of protest )، التي أصبحت أكبر أنتولوجيا في العالم حيث ضمت أكثر من 5300 شاعر من أرجاء المعمورة، وأصبح للمحتجين منظمة تعرف بـ(شعراء ضد الحرب) لها موقعها الإلكتروني ومواردها المالية، ولم تنس الكاتبة أن تذكر بما جرى من احتجاج عام 1965 ضد الحرب على الفيتنام، وقد أرفقت مقالها بإحدى رسائل المنظمة كنموذج على مجهوداتهم وختمته بقصيدة (ضباب أزرق) للشاعر كوري ووكر.
القلم وما يسطرون
ما تزال الشاعرة والناقدة فاطمة ناعوت تدهش وتندهش، وتشبه الحياة أحيانا حينما تكسر منظومة التوقع و المنطق وإنها في آخر محطة من هذا الكتاب (القلم وما يسطرون) توحي لنا بالعودة إلى ما قبل البدايات، إلى زمن الحديقة الأولى واللحظات الأولى. إنها ما تزال تكتب قصائدها بالفلم، وما يزال للقلم ذلك الحضور المدهش، وما تزال للكلمات والحروف احتمالاتها التي لم تكتشفها الشاعرة بعد. هل لأن “الحروف سقطت من تاج الله و نقشت فوق فلم مصنوع من لهب النار” ص 87، أم لأنها تحرص على التمسك بالدهشة. تقول الكاتبة في محطتها الأخيرة هذه، “أفعل ذلك لأنني لو فقدت الدهشة بالأشياء اعتدتها، ولو اعتدتها مججتها” ص 221، وهكذا “أسلم كل شيء لسلطة الكي بورد” إلا قصائدها فإنها ما تزال تخطها بيمينها، ما تزال تخربشها، ما تزال “تحافظ على دهشة اللحظات الأولى” إنها تذكرت مراحلها الأولى، وهنا نسألها بكل ما غرفناه من البئر الأولى، هل تؤمنين بقول كونديرا “الذكرى هي شكل للنسيان”. وهنا أيضا نراها تبتسم، نراها تبحث عن القلم، نراها ترسم رسوما أخرى، نراها تتقبل منا بكل ود تهنئتنا لها بهذه الكتابة بالطباشير نراها تقترب من اللوث وتمحو التاء المربوطة من الحروف الأبجدية، وقبل أن تنصرف سنقرأ لها بابتسامة ماكرة “حين تقرأ كتابا فأنت تتجول بحرية داخل أروقة ودواليب دماغ كاتبه..” ص 121.