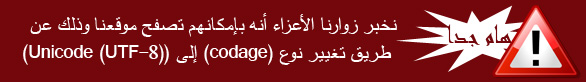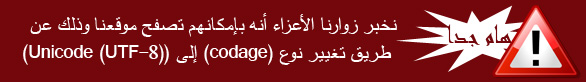بتوقيعها لتجربتها الإخراجية مع فيلم "وراء المرآة"؛ أصبحت الأكاديمية والسينمائية، نادية شرابي لعبيدي، أوّل امرأة تُخرج فيلما روائيا طويلا في الجزائر. وقد نال هذا الفيلم، الذي كتبت له نص السيناريو وأخرجته وأنتجته وشاركت في كتابة حواره، اهتماما واسعا، وأثنى عليه النقّاد وصفّق له الجمهور في غير ما مكان ومناسبة، داخل الجزائر وخارجها، وفي المهرجانات السينمائية العربية والأجنبية.
الجزائر: علاوة حاجي
ويطرح الفيلم، الذي أُنتج عام 2007، مسألة الأمهات العازبات، بشكل يقترب إلى التلميح أكثر منه إلى التصريح. ويدعو إلى تجاوز النظرة السطحية للمجتمع إلى مثل هذه القضايا.
ولم يكن هذا النجاح وليد صدفة؛ فهذه المرأة التي يحيط بها جمهور غفير من الطلبة حيثما حلّت أو ارتحلت، كانت قد عادت في العام 1987 بدكتوراه في فنون العرض، تخصّص سينما، من جامعة السوربون.
قبل ذلك؛ درست نادية شرابي علم الاجتماع بجامعة الجزائر، وهو التخصّص الذي تقول إنه مكّنها من امتلاك "نظّارات خاصة" لرؤية المجتمع. لعلها النظارات نفسها التي استعانت بها لتقتحم المجال السمعي البصري من بوابة الأفلام الوثائقية، مجال تخصّصها الأكاديمي، وأكثر ما يغريها على الإطلاق. وقد عملت بمديرية الإنتاج "الكاييك"، واشتغلت كمساعدة مخرج مع أحمد لعلام، وفي العام 1994 أطلقت مؤسستها الخاصة "بروكوم أنترناسيونال" للإنتاج السمعي البصري، وهي المؤسسة التي أنتجت عددا من الأفلام الوثائقية والروائية، على غرار فيلم "عائشات" للمخرج سعيد ولد خليفة.
وتُزاوج شرابي بين العمل الأكاديمي والعمل الميداني. فهي عضو هام في مجلس المنتجين الأحرار المتوسطيين، "لايباد"، ببرشلونة، وأستاذة محاضرة ومؤطرة بمعهد علوم الإعلام والاتصال بالجزائر العاصمة. وكثيرا ما تسمعها تقول عن طلبتها الذين تحيطهم بكثير من العطف: "إنني أتعلّم منهم أكثر مما يتعلمونه مني". ويعلّق هؤلاء بعبارة مقتضبة: "هي أكثر من أستاذة.. إنها مدرسة!".
وما لا يعلمه الكثيرون أنها ساهمت بشكل كبير في تأسيس المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران، الذي يضيف إلى عمره شمعة ثالثة في جويلية المقبل.
في فيلمها الوثائقي القصير "غريب بجاية"؛ تنفض نادية شرابي بالتعاون مع المخرج مالك العقون، الغبار عن الرئيس البرتغالي الأسبق، مانويل تيشيرا غوميز، الذي تخلى عن الحكم في بلاده عام 1925 وسافر إلى بجاية عام 1931 بنيّة البقاء هناك لبضعة أيام، لكنه قرر أن استقر فيها إلى غاية وفاته عام 1941م.
تقول نادية شرابي: "كنا بصدد إنجاز فيلم عن تاريخ هذه المدينة.. وحين سمعنا بتلك القصة؛ قررنا أن نقتفي أثر هذا الرجل الذي أُعجب بالعرب والمسلمين وقرر البقاء بينهم وأوصى بدفنه في مقابرهم".
لا نسمع في هذا الفيلم أي تعليق من المخرج؛ وحده غوميز يتكلم. فقد اعتمد العمل على حوار أجراه معه صحفي برتغالي ونشره في كتاب.
الغريب في "غريب بجاية"، وهو ما لم تتوقّعه نادية أو أي من فريق الفيلم؛ هو أن هذا العمل الوثائقي القصير، والبسيط من حيث الإمكانات المادية التي لم تكن تسمح بالكاد إلا بإنجاز ومضة؛ حقّق نتائج مذهلة، فقد عُرض مترجما في البرتغال. وكانت النتيجة أن ساهم في نفض الغبار عن الرئيس المغضوب عليه والذي اعتُبرت استقالته وخروجه من بلاده بمثابة خيانة، ومُحي من الذاكرة البرتغالية. وخلال زيارة الرئيس البرتغالي الحالي، آنيبال كافاكو سيلفا، للجزائر، قام بنصب تمثال بمدينة بجاية يخلّد ذكرى غوميز الذي نسمعه يقول وهو يتجه على هذه المدينة المتوسطية الجميلة: "لقد فتحت في حياتي صفحة كاملة البياض، لم أحمل معي كتبا أو أوراق تذكرني بفترة حكمي". كما نسمعه يقول أيضا: "إذا كان عليّ أن أغيّر جنسيتي؛ فإن علي أن أبحث عنها بين المسلمين. كل شيء يدفعني إلى اتخاذ مثل هذا القرار".
.. إنها سلطة الصورة.
العودة إلى الأغواط
وفي فيلمها الوثائقي القصير "فاطمة العمارية"؛ تعود المخرجة إلى مدارج صباها في الأغواط.. هذه المدينة الجنوبية التي تقول إنها مازالت تحمل منها كثيرا من الصور والألوان وأنغام المدائح الدينية منذ عهد الطفولة. وبكثير من الحميمية؛ تُقدّم حكاية فاطمة، الفتاة الزنجية التي تنتمي للزاوية التيجانية بعين ماضي. ترصد الكاميرا بعض صور الحياة اليومية في منطقة محافظة، دون أن تلقي كبير اهتمام للتفاصيل، كل شيء مركز على هذه الزنجية المحافظة والتي تمتلك موهبة الغناء وتحلم بأن تصبح مغنية مشهورة. فيتنازعها صراع بين المحافظة والانفتاح وتحقيق الذات، بين رغبتها في خلع "القمبوز" وإصرارها على العودة إلى عين ماضي مهما ابتعدت عنها.
تقول نادية شرابي عن هذا الفيلم، الذي حاز جائزة على لجنة التحكيم عام 1996 بمهرجان الفيلم الإفريقي بميلانو: "أحب شخصية فاطمة العمارية لأنها سمحت لي بالتعبير عن كثير من المشاعر والأحاسيس.. كنت أذهب إلى مدينة أمي، الأغواط، في طفولتي، ولطالما تمنيت أن أنجز فيلما عن ذلك المكان. وحين التقيت هذه المرأة؛ أعطتني المفتاح لفعل ذلك. إنها بمثابة رأس الخيط..".
فاطمة أخرى تتّبعتها كاميرا المخرجة.. هذه المرّة؛ إلى غرب هذه البلاد التي تقع في حجم قارة. وهران "الباهية"، وبالضبط في مدينة أرزيو، هناك حيث امرأة اختارت الصيد البحري مهنة لها، هي وابنتها خضرة وحفيدتها نجاة. "إنها مهنة لا يستطيع أن يتحملها حتى الرجال بسبب الخوف والمخاطر"، تقول فاطمة التي لا تخفي اعتزازها وافتخارها باسم "فاطمة الحواتة"، لقد أهدت أبناءها معنى العيش بكرامة، تماما كما أهدت المخرجة الجائزة الفضية في مهرجان دمشق عام 1995.
يشترك الفيلمان الأخيران في أكثر من نقطة ارتكاز، فهما عملان وثائقيان يستمدان أدواتهما من السينما، وكلاهما يقدّم حكاية عن المرأة. فهل يشغل موضوع المرأة الحيّز الأكبر من اهتمامات هذه المخرجة؟.
ترفض نادية شرابي ذلك رفضا قاطعا، قائلة: "كوني امرأة لا يعني بالضرورة أن أكون مخرجة أفلام عن المرأة". وتعلن: "لا أقبل أن أوضع في قالب محدّد أو أُصنّف في خانة معينة. أنا مبدعة، والمبدع الحقيقي لا يرتبط بلون ولا تقيّده حدود"، ثم تضيف: "قضيتي هي الإنسان، ذكرا كان أو أنثى أو كائنا غريبا".
بالنسبة لنادية شرابي؛ يبدو تجاوز الخطاب الرسمي الذي يعتمد على مفهوم "الجماهير" أحد أهم رهاناتها، لتطرح "الفرد" كبديل عنه، في إطار نزعة فردانية، باعتبارها فلسفة قائمة على خلق الواحد والالتصاق بالمُفرد فكراً ومُمارسة.
هو خيار إخراجي ولا شك؛ تسليط "زوم" على شخصيّة معيّنة انطلاقا من أحاسيس الفرد. وتضيف: "هناك توجّه في السينما الجزائرية نحو هذا النوع، فقد باتت تولي اهتماما أكبر بالفرد بدلا من الجماعة، بدليل الأفلام التي جاءت بعد "عمر قاتلاتو" والتي يحمل معظمها أسماء علم".
إنها تقدّم حالات بشرية مختلفة حدّ التناقض، غريبة حدّ الدهشة، لكنّها قد تشبه أي واحد منا، تنظر إليها بزاويتها الخاصة وتغمسها في رؤيتها المتفردة، لتُخرجها كما هي، عارية ومجردة. وأبعد من ذلك؛ لا تدّعي أنها تُقدّم نماذج لحالات أخرى مشابهة أو مطابقة.. أو ظاهرة من الظواهر المتفشية في المجتمع، بل لا تمثّل إلا نفسها كتجربة إنسانية مستقلة، دون أن ينفي ذلك، طبعا، إمكانية أن يضعها المتلقي في سياق عام، أو يصبغها بتأويله الخاص.
ميزة الفيلم الوثائقي أنك لا تخلق قصة، بل تجد القصة جاهزة، والمسألة تتعلق فقط بكيفية رؤيتك لها، كيف تنظر للواقع وفق انطباعك الشخصي والفردي. وفي تلك الأفلام الوثائقية الثلاث؛ لا تجد آراء المخرج ومعلوماته وتعليقاته. إنه ينسحب تماما، ولكنك تحس بروحه كخيط رفيع يخيّم في الفضاء. "لم أتدخل بالتعليق، لأن تصوّر المخرج يظهر من خلال البنية".
تماما كما تستعين السينما الوثائقية بالحقل الوثائقي؛ تستمد الوثائقيات السينمائية بناءها وتصورها وسيرورة أحداثها من السينما، لتحقق جماليات أكثر. وتقول شرابي: "الريبورتاج التلفزيوني يؤرخ اللحظة. أما العمل السينمائي فيتطلب دقة الملاحظة واختيار الزاوية لتصوير الواقع بطريقة فريدة"، ولا تخفي إعجابها بفيلم "سنوات المحبة" لعز الدين مدور، الذي خلق ضجة في الأوساط الرسمية الفرنسية، وتصفه بـ"أحد أجمل الأفلام التاريخية الجزائرية".
وهي تفتح خزانتها المليئة بالمشاريع الجديدة والمؤجلة؛ تقول نادية شرابي لعبيدي بلغة الواثق: "أسعى لتغيير النظرة النمطية عن الأفلام الوثائقية، وإعادة المجد إلى السينما الجزائرية..".