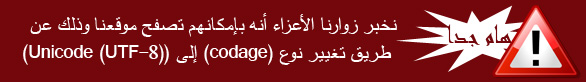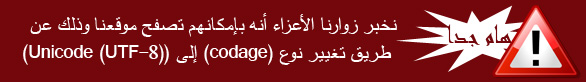المكان: قارة الإمكان المترامية الأطراف والأطياف خلف الوجود. الزمان: بصنمه يتم التقرب إلى الأبدية زلفى بعد استلائها على مفهوم الربوبية مادامت الآلهة قد أصبحت مجرد قطيع من الفلاحين عبر مختلف أصقاع البساتين. ومن تلك الكينونة والحينونة تنطلق الشاعرة سلمى بلحاج مبروك في تسجيل نزهتها الشعرية التي لا تلبث أن تتحول إلى متاهة في سراديب كينونية وحينونية مقفرة مظلمة حيث تكفي رؤية القمر لتأخذ فكرة عما يتواطس تحته من موبقات الحضور المتشظي عبر أطلال ذلك الكون الزهيد المحيط بجميع أجرام وأنام القصيد. هي إذن شاعرة الوجود والعدم والكون والفساد والخصب والرماد والحيوان والجماد. شاعرة عابرة لحواجز المقولات ومستعدة لتباغتك بشعرنة السماء الدنيا حول حضورك الساذج أمام تلك القصيدة قبل أن تتساءل عن ماهية التحليق المناسب لمجاراة ما يطوف حولك من العناصر دون أن ترى لها أجنحة. ولكن اللغز سينحل أمامك عندما تدرك بأن تلك العناصر ليست هي التي تطير وتطوف حولك، بل أنت الذي تشعر بالدوار. وإلى أن تستعد للغوص في سراديب الممكن الفني الشعري من هذا الطراز عليك أن تأخذ قسطا من الراحة أولا. عندما تستعد الشاعرة سلمى بلحاج مبروك لكتابة القصيدة فهي لا تترك من التشكل النمطي للكون إلا باسمك اللهم، إذ تأتي على أخضر المحيط، المشعور به، ويابسه كالنار الموقدة من أجل أن تعيد صياغته كاملا من مبتدأ الجذور إلى منتهى الأغصان. وعندها فحسب تطمئن لتحقق الشروط الانطباعية اللازمة لإلقاء القصيدة. إنها تفكك المحيط برمته وبقدر ما تركب القصيدة. بيد أن جنس التركيب الشعري من جنس التفكيك الكوني بالنسبة للشاعرة سلمى. إنها تمهد الطريق بإحداث انفجارات وانهيارات رهيبة في البنية التحتية للكون. وكل هذا من أجل أن تستبق التقاط الصورة لأنقاضه وتقول لنا: هنا منتهى التشاؤم، هنا إيسكاتولوجيا الخوف والذعر فتعالوا معي أعطيكم لمحة حول طبيعة الأنقاض التي قد يخلفها الانهيار الكوني على رؤوس من فيه. ولا ننسى أن هذه الرؤوس يجب أن تتحول بشكل قبلي إلى جلاميد صالحة لشتى أصناف الاختبارات التخريبية من أجل الوصول إلى إنتاج إنسان من الحجر فإذا به تمثال يُعبد هناك في أسفل سافلين بين ظهران بني أخياف والسفهاء في مدينة ما تقع في وسط قارة الشمس. وبالتالي تأنيب العابدين بشكل تم إضماره في تأنيب هذه الأوثان نفسها عن طريق التحقير والسخرية والاشمئزاز من حجريتها المقيتة مستنكرة عليها التحجر والامتثال لهذا التصميم التمثالي رغم أن الوجود حول هذه التماثيل مهدد بانهيار كاريكاتوري باعث على المهزلة ومثير لسفساف أقصى آيات التسخيف والتسفيه. لا يمكن تأويل قصيدة للشاعرة سلمى بلحاج والكون حي يرزق. لا يمكن الوصول إلى شيء ما لم نتطلع إلى استخراج السياق الوجداني للقصيدة من أنقاض الماهية والهوية والوجود. الوصول إلى حافة التأويلات يجب أن يتم عبر كم هائل من الشظايا والغبارات والدخانات والخذلانات والطغيانات التي انصهرت في سديم واحد وتم إنتاجها في لاماهية واحدة من حيث نقضها لمبدأ الوحدة نفسها. إنها الشاعرة التي تدخل إلى نفسك لتقول عن نفسها، من خلال اللانفسك، ما تريد. تتحدث بلغة مثقلة بإيحاءات ما قبل استقلال الإحيائي عن الجماد. لغة أنثروبوفيزيائية Anthropophysical تنم عن عكس حينونة ما قبل تشكل الخلية الحية. حين كان الحيوي مضمرا في الفيزيائي وموجودا بالقوة في مادة الصخر والنار ككائن فيزيائي ثم كيميائي ثم بيولوجي. من هنا تستوحي نفسية الشاعرة حملات مفرداتها الدلالية. الإنسان في قصيدتها كائن آثاري نياندرتالي لا فرق بينه وبين صخرة بركانية سوى فيما يخص الشكل الهندسي الذي يجعله مرسوما على جبين الصخرة. ولا بأس من تطوره إلى مرحلة العظام على أن تبقى رميمة. لكن الفرق الجوهري بين هذه الحقيقة وما يعكسه منها شعر سلمى هو أن كليهما يحمل ما يكفي من المخرجات عن فلك التاريخ بحيث يضعف القول بانطباقه على الماضي دون الحاضر أو المستقبل. وهذا لعمري نتيجة كونها قد أجهزت على عجوز النحس هذا التاريخ أيضا وألحقته بالوجود الذي صار فعلا عبارة عن عجين من مادة الممكن بين أناملها بحيث لا تفتأ تصوغ منه صورة ما تلتقطه نفسيتها الشاعرة. لا وقت للشاعرة سلمى يكفي لتراقب أو تراعي مدارك القارئ المفترض. فهي متمكنة من الأصول الفنية للشعر وتدرك بأن هوية هذا الأخير فنية قبل كل شيء وأن استهداف الفهم العام البديهي من خلال القصيدة (المفترض أن تكون كلاما فنيا وليس مباشرا عاديا) هو من قبيل عدم القدرة على الغوص اللغوي مجاراة للغوص الإحساسي، هذا إذا لم نقل ناتج عن عدم القدرة الكافية على الحس الدقيق بما هو دقيق وهو الفصل الذي يتقرر فيه الفرق بين الشاعر وغيره. وبناء عليه فإن الشاعرة سلمى بلحاج مبروك لا تحاول التنازل عن التقاط تفاصيل بعض المشعورات من أجل التخفيف عن القارئ(الباحث في بستان الشعر عن أسماك الصحف اليومية) وهذا جانب يستحق المباركة والتشجيع في شعرها. لأن هذا يعني أن المتلقي لشعرها يتلقى شعرا حقيقيا بكل المقاييس ولا مجال للتصنع الذي يؤدي، لا محالة، إلى خلق المشكوكية الأدبية الفنية على مستوى التلقي بقدر ما يتعرض للتخاذل الذاتي الشاعري المؤدي إلى إعطاء صورة يطغى عليها التكلف والتصنع. لا رحمة في قصيدة سلمى ولا شفقة. فالويل لمن يشترط فهما على النص الشعري كشرط سابق للذوق. ولا مجال له بين هذه القصائد إلا أن يغرب عن وجهها غروبا واحدا وكاملا. عندما نقرأ قصيدة للتونسية سلمى فهي تستدعي منا وفينا غريزة احتضان لا مشروط للجمال. الغريزة التي لا تتورع عن ذبح العرف والتقليد والعقل والنقل من أجل الحسن البلاغي الفني المكتوب و من أجل السحر الذي لم يسموه سحرا حتى كان خاطفا للصواب. فلو عرضنا جمال النساء مثلا على محكمة المنطق ما بقي لنا وقت يكفي للزواج بإحداهن. إذا كان لا بد من إعمال غريزة الفهم فيجب أن تعمل لفهم الذي أحدثه هذا الفن في نفوسنا بدل إعماله في فهم ما قاله أو لم يقله القصيد كما قالت الشاعرة التونسية الأخرى "فاطمة بن محمود". هنا الأدب، هنا الثروة الإبداعية في حقيبة هذه السلمى الوعرة الهضاب والأخاذة المناظر التي يتقاسم تلالها بياض الثلوج وفسيفساء ما شئت من الأزهار والفراشات. هي أرضها الشاعرية التي تجري من تحتها أنهار الفن والجمال بعد تخطيك القرائي لكل الأنقاض والانهيارات التي أحدثتها هذه المرأة. ولا ننسى أن الرجم العظيم قد كان المسؤول الأول عن هطول المطر إبان الزمن الجيولوجي بفضل الدخانات التي أحدثها في أرجاء المعمورة التي كانت مخروبة آنذاك. تقول في قصيدة بعنوان "شقائق القمر" (1)
"على سواعد الآلهة
أزهرت شقائق القمر
جدائل المرح
من قلب مروج الثلج الأخضر"
اخضرار القلب يبرر، بقدر ما يلائم، أزدهار شقائق القمر التي انبثقت منه أصلا. وبالتالي فقد مهد لهذا الازدهار نسقيا حتى وإن تأخر من حيث ترتيب المفردات في النص. ثم حتى وإن كان القلب يحمل خاصيتين إلا أن الشاعرة أشبعت به التصوير. فمن الملاحظ أن هذا القلب، من حيث علاقته بالمروج، يلعب دور اللب الوسط. لكن على مستوى علاقته بالثلج يعطينا صورة جانبية تشير إلى برودة ما في موقف ما. وانطلاقا من هذه البرودة، التي هي صفة الماء كما أن الثلج أصله ماء، تفرع هذا القلب كالنبتة لتصبح الإشارة إلى الآلهة انطلاقا من علاقتها به، تلك العلاقة التي أزهرت شقائق القمر بفضلها، منحصرة في التدليل على الدور الفلاحي لهذه الآلهة أكثر من دورها الألو هي أو الربوبي، وبالتالي توجت التصوير بازدهار شقائق القمر. لقد صورت الآلهة وكأنها لا تعدو أن تكون مجموعة من الفلاحين في بستان تمت الإشارة إليه بنفس التجزيء الذي تم عن طريق الإشارة إلى القلب والمنشطرة بين البذرة وبرودة موقف قد يكون ذا صبغة عاطفية. وسرعان ما تنتصر الشاعرة لجانب البرودة من خلال علاقته بالإفضاء إلى العبث فتقول:
"تناثرت في بيداء الروح
أخاديد فجر فسيح متمرد"
الشاعرة تجعل من العناصر الكونية المشعرنة موقفا يحاكي فعل الطبيعة خاصة ما يتعلق بدورة المواسم. وتقوم بقزيم الزمان وحرق المراحل تسريعا من إيقاعها النصي بحيث تعطينا فرصة للكشف عن آلية هامة من آليات بنائها للقصيدة. وهذه الطريقة أيضا تساعد على تعميق خطابها الشعري. لكن في القراءة التحليلية ينبغي أن نعكس الصورة، أي مادام العمق جاء على هذا النحو نتيجة حرق المراحل وتقزيم الزمان، لنستخرج الحادث كما لو أن ما يفصل بين هذه الفصول وقت طويل بما يكفي لملاحظة التغيرات الطارئة. ومن هنا نجد، على سبيل المثال وبفضل افتراضنا القرائي، بأن هناك وقتا كافيا للفصل بين المرحلة التي أزهرت فيها شقائق القمر ومرحلة تناثر هذه الشقائق في بيداء الروح. وباستخدامنا معيار التجزيء السائد الذي عودتنا عليه الشاعرة نتوصل إلى محاكاة التعاقب القائم بين المواسم. وأن المقطع الأول يتضمن الإشارة إلى فصل الربيع بينما تشير، من خلال هذا المقطع، إلى فصل الخريف حيث تناثرت الشقائق في بيداء الروح. عندما ردت الشاعرة على إشارتها إلى فصل الربيع، من خلال المقطع السابق، بالإشارة إلى الخريف في هذا المقطع فإن ردها يتضمن ردا فرعيا على القمر أيضا. فالفجر فسيح لكنه متمرد. وبهذا يصلح أن يكون الحديث عنه ردا على الاستمتاع بالقمر في جو دلالي يضم الأزهار وفصل الربيع والاخضرار. إذن فهذا الرد يوازي ردها، من خلال تمرد الفجر، على القمر وتناثر الشقائق في بيداء الروح. بعد ذلك تواصل السير على نفس الإيقاع الاختزالي لنظام الزمان من خلال حرق المراحل الموسمية بغية استثمار سرعة التعاقب القائم بينها في التعبير عن أحوال وجدانها مشكلة بذلك أبجديات فنية منها تتكون روح اللغة الشعرية الظاهرة للعيان. فعندما ينتهي فصل الخريف يأتي فصل الشتاء. لنتابع مظاهر هذا الأخير في مقطعها الثالث من نفس القصيدة حيث تقول:
"هطل الصبح
على مفترق سناء ضوء فاحش
أريج نبض ندى مترف
زاد شتات هائم
منعش…طري …عبق …مبهم"
الهطول والندى والإنعاش كلها مفردات تشير إلى استحياء موسم الشتاء إتماما لمسلسل أبجديات الفصول التي تعزف الشاعرة، من خلال استيحائها، على الوتر الفلكي لمبدأ التضاد الحاكم لصيرورة القصيدة إضافة إلى العناصر الأخرى. وبهذا تثري عناصر التعبير الفني عن مشاعرها وفي نفس الوقت تستعرض هذا التضاد في إطار موحد على عكس وضعيته من الناحية المرجعية لأسباب سآتي على ذكرها لاحقا. ولكن هذا التصوير يقتضي من الشاعرة اتخاذ موقع ملائم من خلال زخرفة حضورها داخل حرم القصيدة بحيث لا تكون مخاطبة هذه الصور من فوق النص ولهذا تقول:
"في نهم المنظر
أسندت ظهري للزمن العاري
خلطت ذاتي بنسغ الشفق البري
في كوخ الجسد
تركت الروح
تتزلج"
إن حضور الشاعرة بين عناصرها الفنية التي تشكل الموضوع اقتضى منها التحلي بحلة فانطازية من أجل ملائمة ما تكتب عنه، ولهذا نراها تسند ظهرها إلى الزمن العاري بدل الزمن النمطي وتخلط ذاتها بنسغ الشفق البري في كوخ الجسد عملا على ربط صلة التناغم الصوري بين حضورها داخل القصيدة وعناصر الموضوع. في نهم المنظر لم تسند ظهرها للزمن النمطي بل لذلك الزمن العاري الذي من شأن عورته أن تتناغم أكثر مع تحول الجسد إلى كوخ تختبئ فيه الروح. الملاحظ أن تحويل الجسد إلى كوخ يعني قابلية المشهد لخروج ودخول الروح في الوقت الذي تريد( الشاعرة) هذه الروح. وأن ما أرادت هو تزلج الروح في مشهدها الذي عملت جاهدة على تليينه وتعجينه بحيث يصبح قابلا لتمثل مختلجات الشاعرة بأكبر قدر ممكن من المرونة. قد يكون الحديث عن خروج الروح من الجسد حديثا عاديا يفيد الإخبار بالموت، ولكن عندما تصنع الشاعر ة مشهدها الفني الشعري في فضاء الإمكان بدل فضاء الوجود، محولة من خلاله الجسد إلى كوخ، تصبح الروح ساكنة فيه بعد أن تم تشخيصها وإقالتها من مؤسسة الجسد كبعد لا يمكن الاستغناء عنه في عالم الحياة الطبيعية. وهكذا خرجت الروح من الجسد (الكوخ) للتزلج:
"على قارة شمس جعدها
ديكور حزن مستورد
تعزف وشم الماضي
على أكورديون ذكرى نرجسية
في مدينة
نصف سكانها تماثيل
تنبض شهوة رخامية"
عندما يتعلق الأمر بالحديث عن نصف المدينة الذي يتشكل من معاشر التماثيل فلا حرج من الحديث عن شهوة رخامية بالمعنى الحجري وليس بمعني ريح هادئة. لأن التمثال يفترض أن يكون عادة من الحجارة أو ما شابه. ولهذا نرى أنه حتى تلك الشهوة، المشتعلة في أبدان هؤلاء، ليست شهوة حقيقية بل منحوتة فقط وبالتالي فهي رخامية مادامت متعلقة بقوم حجري. وبهذا فإن الشاعرة لا تستهدف، من خلال القصيدة، أي حديث عن النصف البيولوجي السليم من هذه المدينة. وأن كل ما في الأمر هو أنها تعطينا صورة شعرية لذلك النصف اللافائدة ترجى منه. بيد أن حجرية هؤلاء هي المسؤولة عن هذا التحويل السريع للشمس من الجمادية إلى التشخيص. أي من كونها قارة (أو بالأحرى تغطي قارة) إلى عزوفها لوشم الماضي على أكورديون الذكرى النرجسية. حتى الحديث عن الحزن وعلاقته بالتجاعيد يجعلنا نتصفح تشخيصا للشمس قبل مرحلة العزف، لأن الحزن من بين الأسباب المؤدية إلى ظهور التجاعيد في وجه الإنسان. نصف الشمس الواردة مشخصا كما أن نصف المدينة محجرا وكأنها تقيم تضادا موازيا للتضاد المعجمي على هذا الأساس أيضا. تتحول الشمس إلى شخص عازف لوشم الماضي على الأكورديون. لأن النصف المستهدف من سكان المدينة يحتاج إلى إعادة التأنيس والتشخيص. والفرق بين النصفين هو أن الأول مضمر والثاني مظهر. كما أن الأول معنوي والثاني لفظي. إن النصف الحجري لأهل المدينة لا يملك إحساسا بطبيعة الحال، وهذا يعني أن الحزن المفترض إسناده إلى حضرتهم حزن مزيف مثل الشهوة الرخامية أو لنقل كما قالت الشاعرة (حزن مستورد) فهو مستورد إذن لم يتجل أثره إلا في الشمس أثناء مرحلة تشخيصها. أي من خلال النصف الزمني الذي تمت فيه أنسنتها. وبالتالي فهو مستورد عليهم لعدم وعيهم بما يدور حول الديار بنفس ما هو مستورد على الشمس التي تأسفت نيابة عنهم لما هم فيه يعمهون. هناك هرمية بيانية توفقت فيها الشاعرة. وهي أننا نجد عالم الألوهة على قمة الهرم. وهذا العالم يقابل عالم التماثيل في قاعدته. لقد تم عرض هذه الألوهة بصيغة الاستخفاف والاستسذاج، لأن الشاعرة مشغولة بتسجيل أكبر قدر ممكن من الاستسذاج لهذا الجانب المهجور المقفر من الكون وليس من العدل الجمالي الحديث عن الله في مقابل أناس ليسوا بشرا أصلا وإنما هم مجرد تماثيل. ثانيا هناك توافق فني آخر ترتب عن السابق وهو التزييف السماوي المتمثل في انتشال الآلهة من أسفل الطبقات الجيولوجية للذهن البشري بعد أن كانت هذه الظاهرة قد أكل عليها الدهر وشرب. هذا التزييف السماوي الميتافيزيقي الذي حدث على قمة الهرم قد أنتج تزييفا أرضيا فيزيقيا في قاعدة هذا الهرم. وهو تزييف نصف سكان المدينة المتمثل في التماثيل. مع العلم أن الباطل لا ينتج عنه إلا باطل. ولهذا فإن التزييف السماوي في أعلى القصيدة ( هرم النص) لا يبشر بخير في قاعدتها. وها نحن نجد أن الحديث عن الآلهة يناسب النصف المستهدف من سكان المدينة أو التماثيل الكرام. بيد أنه حتى البرودة المشار إليها في المقطع الأول بالثلج قد تبلورت في تلك الشهوة الرخامية في قاع القصيدة. وكأن الشاعرة فتحت شاشة الوجود على الآلهة وما يفترض أنها خلقته من التماثيل المضحوك على أمرها ثم حاولت جاهدة أن تجد في هذه الشاشة ما يعكس حالتها الوجدانية قبل أن تأتي على الأخضر واليابس بأن أنهت الثلج في الرخام و أجهزت على قدرة الآلهة الهندسية بحيث حرصت على زرع ما تيسر من الشك حتى في القوى العقلية لهذه الآلهة. لم لا مادامت هذه الآلهة قد فشلت في إنجاز فعلها الألوهي المؤدي إلى خلق نصف المدينة على هيئة الآدميين الحقيقيين في حين نجحت في لعب دور الفلاح وهو دور يقع في حضيض الوظائف البشرية وإن كان ذا أهمية أساسية في الحياة طبعا. بهذا تستعرض الآلهة من أجل الإجهاز البلاغي عليها ومن أجل تتفيه حتى ما أشير إليه من الاستمتاع بمشهد شقائق القمر والذي نتصفحه في قاعدة الهرم بشكل أوضح. لقد بدأت هذه الآلهة نشاطها في فصل الشتاء لتفصح عن خرفها في فصل الخريف حيث امتزج تخريفها الربوبي بخرف الشقائق التي نجحت في فلاحتها. النقطة الإضافية هي أن التماثيل المتحدث عنها في هذه القصيدة ليست تلك التماثيل البريئة المصممة للديكور، بل إنها تشير إلى دور إشراكي شركي ومظهر من مظاهر الزنقدة في وجه الواحد الأحد. وهذا يعني أن تجريد نصف المدينة من أدميته معوض بشكل أسوأ. ألا وهو أن نصف المدينة الأخر المعترف بآدميته يفترض أنه قائم على عبادتها والطواف حول زيفها تقربا إلى تخريف الآلهة المتعددة الجنسيات والتي قلنا أنها قد تم تجريدها من قواها الألوهية والعقلية وبالتالي تقزيمها إلى مجرد جماعة من الفلاحين في إحدى البساتين السماوية هناك على مقربة من كوكب القمر. بهذا تجبرنا القصيدة على الانعطاف نحو المستهدف المضمر من خلال المستهدف المظهر. فما دامت التماثيل لا تقدم ولا تؤخر في الأمر مثقال خردلة فإن المخاطب المضمر هو النصف الآدمي الحي من هذه المدينة. وهكذا تنزل القصيدة تأويليا إلى مستوى الخطاب المباشر لتقل بأن هناك نخبة من المعبودين يجب التخلص من عبادتهم الباطلة. فهم وما يقربونكم إليه زلفى باطلون أجمعون. فلا هؤلاء المعبودون والمسجود لهم من دون الله حقيقيون ولا تلك الآلهة، المتقرب إليها زلفى، من خلال هؤلاء التماثيل، تستحق عبادة. لأنها لم يتبق من دورها الألوهي، بعد أن تم تقزيمه إلى دركة الدور الفلاحي، إلا باسمك اللهم. وبهذا تدور القصيدة حول موضوع يتجسد في بطلان وراء بطلان إلى ما لا نهاية. تسير القصيدة في منحى تنازلي، من حيث استغلال عناصر المحيط، كالتالي:
1. على المستوى الطوبوغرافي:
الألهة
↓
القمر
↓
البيداء ←المدينة
2. على المستوى المعنوي:
الآلهة
↓
المرح
↓
الروح
↓
شهوة/ رخامية
تماثيل/ إنسان.
هذا ما دفعني لأتفحص الوضعية التي وردت فيها الشمس لأكتشف أنها لا تشير إلى قرص هذه الأخيرة، رغم الانزياحات المغرقة لدى الشاعرة التي لا يستبعد معها القول بأنها تقصد ذات الشمس، بل تشير إلى القارة ( يجوز أن تكون الإفريقية) التي أحرقتها الشمس. عندما قالت "قارة الشمس" فإن الشاعرة لم تصور هذه الشمس كما لو أنها كوكب مقسم الجهات على القارات. بل تقصد القارة التي أكلتها الشمس. ومن المعلوم أن القارة الإفريقية، على سبيل المثال والتبسيط، تقع معظم أراضيها تحت رحمة الشمس (الحر المفرط). وبالتالي فإن القصيدة، انطلاقا من هذه الإشارة، يجوز أن تصب جام استهدافها على هذه القارة التي تسمى القارة الكسولة، والتي لا عجب أن تحتضن مدينة منشطرة بين الأوثان وغيرها ممن بعبدونها من دون خالقهم. في هذه القصيدة يمكن رصد مبدأ تلحيم المنقسم في حرق المراحل بين المواسم المستوحاة. لقد تمكنت الشاعرة من تعميق خطابها الفني في هذه القصيدة من خلال هذا الحرق المتجلي في تسريع الذبذبات الزمنية في النص مما أنتج انزياحا واضحا في التصوير والذي يظهر بأن القصيدة غارقة في الغموض. عندما نوحد بين فصل وأخر مثل الربيع والخريف على سبيل التوضيح يتبين لنا بأننا أوصلنا في القصيدة بين منفصلين على مستوى المرجع. وإذا لعب هذا التصوير دورا أساسيا في خلق الجملة الفنية من حيث انزياحها عن الجملة العادية فإن ما سيأتي يتفق تماما مع هذه النقطة. إذا بحثنا عن سبب تسريع ذبذبات الزمن النصي، في هذه القصيدة، نجد أنه يكمن في عكس حالة الشاعرة النفسية لبطء الزمن المرجعي (الحقيقي) الذي تتكرس فيه الأوضاع المرفوضة لدى الشاعرة. ولهذا يمكن القول بأن تسريع ذبذبات الزمن المؤدي إلى فرز الصورة الفنية في هذه القصيدة يعكس عدم حصول ذلك في الواقع بحيث يؤدي إلى تغيير الأوضاع المملة والمرفوضة. ومع ذلك فقد جاءت الإشارة اللفظية إلى هذا المبدأ من خلال قولها مثلا:
"في مدينة
نصف سكانها تماثيل
تنبض شهوة رخامية"
ففي هذا المقطع نرصد جمعا بين الحيوي والجماد. وهذا يوافق باقي الإشارات المماثلة في قصائدها الأخرى. في قصيدة بعنوان " صلاة الحب الغائب" (2) تقول:
"أراك في وجه القمر
قلادة من نور في جيد العمر"
أثناء الليل حين يشتد السكون والسكينة يكون للشاعر فرصة ليرى ما لم تتيسر رؤيته خلال غبار النهار وجعجعاته . الشاعرة ترى ما ترى في وجه القمر الفارض نفسه على قبة السماء، نتيجة قربه من الأرض والمشاهد المناجي الليلي لكائنات عالمه الخاص. تلك الكائنات التي تحول إليها الإنسان المعتاد عن طريق استبطان محاسنه أو مفاسده إن اقتضى الأمر. بيد أن الشاعرة تنظر إلى القمر لكنها ترى العمر شاخصا مشخصا شامخا وقد استكمل زينة هندامه بقلادة نورانية صارها المخاطب بنفس القدر الذي صار به القدر بشرا. فلولا غاية إعادة التكوين الأمثل للمخاطب في ذات العمر المؤنسن ما تم اختزاله في قلادة حتى وإن كانت نورانية. وفيما يتصل بالجوهر الذي تقوم عليه هذه الدراسة نجد أن تشييء المخاطب عن طريق اختزاله في القلادة النورانية يقابل تأنيس العمر وهذا يعني أن الشاعرة قد جمعت بين المعين والمجرد في هذه الصورة وهما الإنسان والعمر. وهو جمع يعكس ما تستشعره الشاعرة من المرجع الواقعي من شبه العجز عن حسن استغلال هذا العمر.
"تحتسي خمر القدر
تمشط عشب السحاب الأخضر"
كأن الدور الوجداني المتوقع من المخاطب أن يلعبه فيما يأتي غير مسموح بإتمامه على أكمل وجه مادام القدر مادة غير مؤدية إلى الثمالة. ولهذا توجب عليه أن يصبح نبيذا أو منتجا للنبيذ الذي ترى الشاعرة مخاطبها يشربه لكي تصبح خوارقه الشعرنية مبررة أمام جنازير القدر المهيمن على مملكة الواقع المعيش خارج القلب. أصبح المخاطب عمرا كاملا من الفن الشعري بعد أن كان مجرد قلادة قبل إدراجة ضمن القصيدة، فلا ضير أن يصبح شخصية خارج القيد الحيوي لتنفتح على الهوية التشكلية الأوسع للوجود فإذا نحن أمام كائن ذي جنسية كونية واللاكونية معا. هو مواطن للوجود بقدر ما تعكسه العناصر المشكلة لذاته المشعرنة. وها هي عناصر الكون تتشخصن وتتأنسن أمامه حسب ما يقتضي مقياس الشاعرة الخيالي الفني الذي هو استجابة لماهيات المشعورات الناتجة عن احتكاك العنصر الكوني بالعنصر الوجداني. المخاطب يمشط عشب السحاب (الأخر) بدل أن يمشط شعره استكمالا لترتيب الهندام وقد صار عمرا للشاعرة في هذا الليل المقمر، ولكن ما كان من الجمال أن يمشط شعرا وقد خضع بين ضفتي القصيدة لمبدأ العبور الكلي للحواجز الفاصلة بين البيولوجي و الفيزيائي من جهة، والفاصلة بين المعقول والمخيول من جهة أخرى. لقد كان من الأجمل أن ألا يكون فعل المشط عاكسا لحركة المخاطب فقط بل عليه أن يتضمن عكسا لفعل الشاعرة الشعري وهذا الفعل يتجلى في انتقال شَعر المخاطب إلى عشب السحاب بقدر ما صار السحاب تربة صالحة خصبة لإنبات العشب. وبقدر ما تحول المخاطب نفسه إلى قلادة نورانية في جيد القدر الذي أصبحه فيما بعد. فلو كان الحديث عن مشط الشعر لأصبح هناك تنازل فني شعري بياني عن مبدأ تضمين الفعل الشعري لفعل المخاطب تجاه العناصر التي تشاركه متن القصيدة.
"ترتق ثوب السهر
تجهض بريق الليل السرمدي
في وجنتي حلم خريفي
تريق
أكواز رضاب السحر
وفي ازدحام الليل
كانت مناكب الظلمة الزرقاء
تتدافع في مآق النجوم الكستنائية"
السهر أصبح يحمل طابعا ماديا بعد أن تم تعيينه بقدر ما حمل الإنسان طابعا جماديا قبل أن يتم تجريده، معادلة رائعة تفصح بنفسها، في إطار تبادل هذا النوع من الأدوار، عن أن المبدأ الرئيسي في شعر سلمى بلحاج مبروك هو مبدأ تلحيم المنقسم أو توحيد المنفصل. وإني لا أرى في علة المظهر الذي أخذه في هذه القصيدة ما يخالف علة تسريع الزمن في قصيدتها السابقة ( شقائق القمر). إذا تم تعيين السهر في هذا الليل، الذي يعج بالشعر والجمال السابح في فلك الخاطر بحثا عن الذات المستعدة لتقمصه لكي يصبح جسدا بروح بعد أن كان في عالم الأرواح بلا أجساد، فيبدو أن نفي هذا السحر يستدعي نفي التعيين عن السهر مثلا بالنظر إلى التفاعل العميق الجوهري المحكوم بمبدأ تلحيم المنقسم. المخاطب يكفي أن يرتق ثوب السهر بعد أن مشط عشب السحاب لأنه متشظي الماهية مقحم الحضور في كل أصقاع وتفاصيل الوجود. بيد أن حضوره، المؤثث بحضور الشاعرة الطافح كيله داخل القصيدة، قد جعل انسيابيته تتحدد بانسيابية الخيال الفني لدى الشاعرة. فكل ما توصل إليه خيالها الشعري يمكن أن يحتضن شظية من حضور المخاطب. بعد ذلك يجهض بريق الليل السرمدي فإذا بهذا الليل امتداد لثوب السهر الذي تم رتقه توافقا وتماشيا وتناغما مع إشكالية الحضور والتفاعل العاطفي الموجه إلى المخاطب الذي مشط عشب السحاب ورتق ثوب السهر. وكأن الكائن الذي صاره في نفسية الشاعرة قد قام بهذه الحركات الهندامية مساهمة في خلق مزيد من الأرق لدى الشاعرة. النجوم عيون جاحظة دامعة لكن ما ينسكب من مآقها ليس دموعا بل مناكب الظلمة. وإذا كانت الدمعة في العين تشوش الرؤية فإن الظلمة ضد الضوء عموما وليس النجوم فحسب.
"وافترقنا عند نقطة التقاء
وجه الثريا كان بدرا مستديرا
يقلب سره الحافي
الشراع
في هذه الكثبان من وهج العذاب
افترق اللقاء
غرقت صحراؤنا
توارت الذكرى كمارد يتسكع
في سحب متورمة بالضجر"
…
ينفجر هذا الجانب الدامس من الكون انفجارا شعريا فإذا الكثبان منفصلة عن الصحراء وإذا الصحراء غارقة بما تتضمنه من الإيحاءات المعكوسة. فبدل أن يغرق فيها الغارق الحي غرقت في إحساسه تماما كما افترق اللقاء بدل المفترقين قبل ذلك. عبر تناسخ الأرواح الشامل تتوارى الذكرى كمارد (بيولوجي) ولكن أين يتسكع؟ في سحب متورمة بالضجر. فها هو الضجر ينطبق على السحب بدل انطباقه على الشاعرة، وها هي الصحراء تغرق في بحر إحساسها بدل أن تغرق هي أو مخاطبها. كل هذا يدل على تبادل الأدوار الانفجارية بين الأحياء والجماد وبين المجردات والمعينات. ومن هنا يأتي تلحيم المنقسم، أي إذا كان المخاطب قد انفجر حضوره وتشظى عبر أصقاع وتفاصيل الكون كما رأينا أعلاه فإن الصحراء قد انفجر مفهومها بحيث أصبحت الكثبان تشكل شظية مفهومية بعيدة عما تبقى من المفهوم العام للصحراء وقس على ذلك في شأن تلحيم بين منقسم الفعل والفاعل الكامن في اكتفاء الشاعرة بإسناد فعل الافتراق إلى اللقاء عوض الملتقين ! فهذا يعني أنها وحدت بين الفعل والفاعل تماما كما وحدت بين الانفجار والتشظي الذي يطال المخاطب وبين الجماد وغيره مثل الصحراء الخ. ولا ننسى أن إسناد فعل الغرق إلى الصحراء يعتبر توحيدا بينها وبين الحي الغريق. وهذا ما أعنيه بتلحيم المنقسم. بعد ذلك تعود الشاعرة إلى محطتها النفسية لحظة استراحة وتقول:
"اقترفنا اللقاء…
اقترفنا الفراق"
بهذا تعود الألفاظ إلى وضعيتها الطبيعية، وفق المد الفني وجزره، لتعود الشاعرة أيضا إلى وضعيتها الطبيعية وإذا بالمقولات تأخذ قسطا من الراحة كما تأخذ الشاعرة قسطا من الهدوء قبل استئنافها رحلة الغرق في عباب تلك اللحظة الشاعرية الضاجة بأكثر ما للطيف من ألوان وما للأجرام من أشكال هندسية فتقول معبرة عما انتهى إليه تفاعلها مع الأرق الناجم عن مناجاتها الأحادية للمخاطب الغارق في الغياب كما غرقت في الحضور أمام محكمة الليل الموقرة قائلة:
"أيها المدثر بالصقيع
يا من تخثرت في عروقه السماء
وغرف من صبابة الأحلام
لآلئ النور المغرد في المساء"
آخذ هذا المقطع برفق وأنا أحس بالخوف من أن يتسرب شيء من بين يدي فيضيع مني كما يضيع الماء بين كفين. كيف تخثرت السماء في عروق إنسان وهي سماء؟ إنه تعبير عن غزارة ما تلقاه المخاطب من الصقيع (البرودة). ومن المعلوم أن الصقيع يأتي من السماء، فإذا كثر بحيث أدى إلى تخثر أو تجمد العروق أصبح المصقوع وكأنه قد تلقى كل ما تنطوي عليه السماء من الصقيع. من هنا تكون السماء كناية عن كل الصقيع. الشاعرة سلمى متعِبة الفن الشعري. مرهِقة الحس الإبداعي. لا تكاد تلتقط أنفاسك من تسلق هملاياها وتلالها وتحدي حافاتها حتى تجد نفسك أمام أشد جبال انزياحها شهاقة ووعرة وخلابة. وهكذا تستمر في آهاتك إلى أن يغشى عليك في إحدى مصبات الشلالات الانزياحية الجمالية. ما إن تحاول الإمساك بلآلئ النور هذه، التي اغترفها المخاطب من صبابة الحلم، حتى تغرد بين يديك وتصبح طيورا يمكن أن تطير وتضيع منك في أية لحظة تهاون قرائي. وعندما نتساءل من أين استلهمت الشاعرة تغريدات اللآلئ؟ نجد أن الأمر يتعلق بالنجوم التي يشبه اصطفافها في السماء اصطفاف الطيور !! والأجمل من ذلك أن فعل التغريد مسند إلى النور وليس إلى النجوم. فالنور واحد حتى وإن كانت النجوم متعددة. وما دامت النجوم مضمرة فقط في اللآليء و مستوحاة من السماء، التي هي أيضا جاءت كناية عن الصقيع، كان من المناسب أن تكون النجوم بعيدة عن مستوى الإشارة الصريحة إلى الطيور بأخذ التعدد بعين الاعتبار. هذا هو الانفجار الذي لا يمكن فهمه ما لم نفترضه شظايا في انتظار جمعها وتوحيد منفصلها. فعندما ندرك بأن الكثبان قد انفصلت عن الصحراء وأن اللقاء قد انفصل عن الملتقين، (وهو ما يعني تحليلا بأن الصحراء قد توحدت مع الإنسان داخل القصيدة في سديم المخيول كما أن اللقاء قد توحد مع هذا الإنسان بالنيابة الفعلية الموكولة إليه ) نكون مستعدين لمزيد من تلقي الشظايا وبالتالي نعرف أين نضهعا على سبيل إعادتها إلى مكانها الطبيعي وقد أخذنا منها رسالة الشاعرة. إذا كان الأمر كذلك فلا عجب أن نجد التغريدات قد انفصلت عما يحيل عليه التعدد النجومي من الطيور بالإضافة إلى غياب ذكر النجوم (بل تمت عن طريق استعارة من خلال قولها لآلئ النور).
"يا من تغطت بعريه الأيام
وتنطعت فوق حاجبيه
غزارة الإبتداء…
غزارة الإنتهاء…"
الأيام تعج بصور المخاطب كما ولدته أمه. لا شريك له في القصيدة. تغطت الأيام بهذه الصور بحيث لم يعد هنا مجال لرؤية من تحويه تلك الأيام في طيتها من الأشياء سوى الشخص الموضوع. وإذا كانت هذه الأيام قد تغطت بصوره( عريه) فإن هذا الأخير بالعكس لم يعد هناك ما يحجب منه شيئا عن الذات الشاعرة نتيجة التعلق الوجداني به. وفوق حاجبيه ترتسم نقطة التقاء طرفي الدائرة التي تسبح فيها الأشياء معيدة نفسها ومكررة طبيعتها دون أن يتغير شيء من شأنه أن يفضي إلى تطور ما في جدوى التعلق الذي لم يفلح إلا في أن يتحول إلى الأرق. من هنا تنطلق البداية إلى أن يتعب المبتدئ فيرتطم بالنهاية التي ما هي إلا نقطة البداية من الصفر. وهكذا تكون هذه السلمى متقنة للكتابة حول اللاجدوى الذي لا فرق بين يمينه ويساره ولا تباين بين شرقه وغربه. ننتقل إلى قصيدتها بعنوان "غزة ...يا عروسة السماء"(3) حيث تقول:
"وضعوا على جبينك المكلل
بروائح الأنبياء والشهداء
جماجم الليل
حفروا في مائك المقدس
كل أصناف مؤامرات عمى الألوان
نفثوا عواء الظلمة
في مدينة الشفق الخرافي
ذات أصيل مكفهر الوجه
بزغت ظلمة شمس عابسة
انتشر ضوء ظلامها
في هشيم الصمت"
وتسير على نفس الإيقاع لبعض السطور قبل أن تدخل إيقاعا آخر كما سيأتي الحديث عنه لاحقا. في هذا المقطع نجد الشاعرة تعبر عن حضور غزة في الزمن الراهن بآلامها وعذاباتها القائمة المشتعلة. وبالتالي فهي تصوغ هذه الآلام وتلك العذابات بصيغة تشاؤمية تكتفي بوصف ما حدث بلا حول ولا قوة. ولكن هذه القصيدة، كغيرها مما قرأت من شعر سلمى، خاضعة لمبدأ التأرجح القائم بين النقيضين والمتمثل هنا في تأرجحها بين الصيغة التشاؤمية لوضعية غزة المزرية والصيغة التفاؤلية التي تأتي بعد ذلك مباشرة. وهذا ما أشرت إليه بالإيقاع الآخر. لتوضيح هذه النقطة نأخذ مثالا من المقطع الموالي حيث تقول:
"يا غزة
يا مدينة بحجم اللامتناهي
ترقد
في حضن الله بسلام
رصيدها البنكي
دماء طرية بيضاء
تهطل من الأرض على السماء"
من الواضح أن الحديث هنا عن غزة قد أخذ صيغة تفاؤلية تقع في مقابل المقطع السابق. وعندما نعمق التحليل أكثر نجد أن التصوير يقوم هنا على قلب طوبوغرافي لما يربط الأرض بالسماء. فعندما تقول الشاعرة، في البيت الأول، الذي يتشكل منه العنوان،"غزة يا عروسة السماء" فهي تصور الوضعية السياسية التاريخية المقلوبة التي أفرزت كل هذا الخراب والتخريب. لاحظ أنها عندما تتحدث عن غزة باعتبارها عروس السماء تبدو كأنها جعلت السماء مكان الأرض. وبالتالي تكون الأرض فوق السماء. إذا تسألنا لماذا تقع الأرض، في هذا التصوير الفني، فوق السماء؟ يأتي الجواب أن الأرض تعبر عن وضعية (أرضية) البديل المتمنى والمتطلع إليه من خلال النص. ولهذا فإن الأرض (الوضعية) المرجوة أصبحت مكان السماء وأن الأرض (الوضعية المستعاذ بالله منها) موجودة بشكل مضمر في السماء التي أصبحت غزة عروسا لها (فيها). لهذا كان من طبيعة الفنية، المخضوع لنسجها في النص، أن تتهاطل الدماء من الأرض على السماء وليس العكس ! لقد أعطتنا الشاعرة، من خلال هذا المقطع، لمحة حول حالتها النفسية وحضورها الوجداني في زمن التشكل الشعري الوارد في هذه القصيدة. وها هي تتحدث عن هطول الدماء من الأرض (البديل المضمر التطلع إلى نيله) على السماء التي أصبحت سماء سفلى. والتي ما هي إلا الأرضية التاريخية السياسية التي يتعذب فيها أبناء غزة. ومن أجل تحقيق دقة التمييز بين العناصر المقدر انتماؤها إلى الأرض، التي أصبحت مكان السماء وفق المبدأ الذي أشرت إليه، كان على الدماء ألا تكون حمراء من أجل تحقيق مبدأ تحول الأضداد المتمثل هنا في اللون الوارد. فإذا كان اللون الأحمر يعبر عن الموت فإن اللون المقابل هو الأبيض. ولهذا نرى هناك تحولا تم تحقيقه، في هذه الجزئية، وفق ما يمكن تسميته الاستصحاب، أي أن التحول الطوبوغرافي للأرض إلى السماء قد أنتج تحولا لا يقل تضادا في لون الدماء. وإذا كان تحول الأرض، المتهاطل منها الدماء، إلى السماء تعبيرا عن الوضعية المرجوة والبديل المتطلع إلى تحصيله من خلال القصيدة، يعبر عن استغلال المبدأ الطوبوغرافي لتصوير الأرض (الوضعية) المرجوة في الأعلى والأرض المستعاذ بالله من شرها المستطير في الأسفل، فإن الدماء تحولت، وفق نفس المبدأ، إلى اللون الأبيض تناغما مع وضعية الأرض المرجوة التي تهاطلت منها على الأرض المكروهة والتي وصفتها الشاعرة بالسماء. إذا تساءلنا لماذا تهاطلت هذه الدماء أصلا من تلك الأرض ما دامت تعبر عن البديل المحمود؟ يأتي الجواب أن العلو الذي وصفت به الأرض المحمودة يعبر بنفسه عن الوجهة التاريخية المتطلع إليها. لأن الشاعرة، حتى وهي غارقة في فضائها الوجداني الشاعري، تخضع مبدأ الخلاص لقواعد منطقية تاريخية نوعا ما قابلة للتحقيق على الأرض. ولهذا فهي تعبر، من خلال إعلاء الأرض وجعلها مكان السماء، عن زمن تاريخي يصبح فيه دم الشهداء الأبرياء، الذين يتم ذبحهم الآن، مفخرة لأهل غزة المستقلة والمحررة غدا. ولهذا تأتي الدماء بيضاء مجردة من علامة الخطر (اللون الأحمر) لأن هذه الدماء حينها سيصبح استعراض ذكرياتها مبعثا على الفخر والشعور بمزيد من قيمة الحرية التي تم الفوز بها أخيرا. لا ننسى أن هذه الدماء تصبح رصيدا بنكيا! لنتابع وضعيتها في القصيدة وقد أفضت بنا إلى زمن الحرية بحيث تحولت إلى مطر الغيث بموجب تحول الألم إلى أمل.
"غزيرة مدرار
عبيرها عطر الخلود"
بهذا نفهم جيدا لماذا كانت دماء بيضاء كما نفهم أكثر لماذا تم استغلال البعد الطوبوغرافي لتصوير أرض غزة. فها فهي الدماء (الأمطار) الغزيرة التي تتهاطل من الأرض (المستقبلية) على السماء (أرض الحاضر) تضيف إلى الصورة صبغة الخلود إضافة إلى حجم غزة الذي يساوي حجم اللامتناهي. كل هذا يؤكد بأن السماء التي صارت غزة عروسا لها (فيها) هي الوضعية السفلى التي أصبحت فيها غزة. وأن النزول بهذه السماء تم من أجل الصعود بتلك الأرض (المتطلع إليها) !
"غزة.... يا عروسة السماء
يا وشاحا مطرزا بصبر الأنبياء
...يا مدينة مستعصية
شفّرها الصمود
يا فاتنة الشهداء ...
متبرجة
بدماء
زكية مباركة
مزاجها كافور
تطهر الذنوب
اغسلي
بدماء ورودك البرية"
نبدأ من البيت الأخير حيث تتحدث الشاعرة عن غسل العروس. بعد أن لعبت الدماء دور المطر، من خلا هطولها السابق، ها هي تلعب دور الماء من خلال الحديث عن الغسل بها. لنبسط الأمور.الزمان عند الشاعرة يخضع لترددات عالية جدا وإذا أبطأناه كما نبطئ لقطة مسرعة على شاشة التلفيزيون من خلال "الريموت كنترول" نصل إلى التالي: العروس، من خلال اللقطة الأولى، موجودة في أرض الحاضر التعيس. وبعد هذا ندخل بسرعة في مشهد اللقطة الموالية وهي أن غزة (في أرض المستقبل) أصبح بإمكانها أن تغتسل بهذه الدماء ( تفتخر بها). فمن الملحوظ أن هذا المقطع يقوم على استغلال إيجابي متفائل لجحيم غزة وهذا كله جاء بفضل وقوع نفسية الشاعرة تحت الذبذبة الإيجابية للمشهد الشعري. عندما تستعرض صبر لأنبياء والشهداء بهذا الشكل فهي تفسر لنا أكثر المبدأ الرمزي الذي تحولت بموجبه الأرض إلى السماء وتحول اللون الطبيعي (الأحمر) للدماء إلى لون مصطنع (الأبيض). إذا كان هناك تقابل بين السماء والأرض ظاهر فهناك تقابل مضمر مواز بين الحاضر والمستقبل. ولكن ليس كل المستقبل بل المستقبل المرجو لغزة وأهلها. إنه مستقبل الخلاص الذي يوازي الأرض التي أصبحت تساوي السماء. من المعلوم أن الورود هنا استعارة تدل على الأبطال الذين ضحوا من أجل الحق في غزة.
وإذا كان في الذكريات ما يؤلم فإن الشاعرة قد دخلت في تصويره كالتالي:
"أدفني موتهم الأبدي
في مقبرة الليل بلا عنوان
حلي عليهم لعنة الغسق
أتركي زهور البرتقال
تروي حكاية
تطهيرها العرقي"
أتركي زهور البرتقال( التي عبرت عنها قبل قليل بالورد) تروي حكاية ما جرى بشكل يبعث على الشعور بما يحكى أن...الخ. إن غزة التي تهاطل عليها الغيث (الدماء البيضاء) من الأرض التي حلت محل السماء يتم استعراضها الآن، من طرف الشاعرة، بشكل يلمح إلى إماطة الشحنة المؤلمة عن ذكراها، وهي شحنة الموت. أي دفن الموت الذي كانت قطعان الكلاب المسعورة الصهيونية تسلطه على كل طفل وامرأة وشيخ بدون وجه حق. ثم تدعو هذه الغزة، بعد افتراض غسلها وأخذ زينتها كما تقدم، إلى قص الحكاية على ألسنة زهور البرتقال( الجيل القادم) ومن المعلوم أن الحادث عندما يصبح حكاية يكون أقرب إلى بث المتعة في النفس حتى وإن كان مأساوي المتن أو على الأقل مجرد تحوله إلى حكاية قابلة للقص يكون منسجما مع الشق المتفائل لعرض الصورة الشعرية في هذه القصيدة. ليدفن ذلك الموت الذي كان أبديا في مقبرة ليل بلا عنوان. أي ما تبقى من ظلام الليل تجهز عليه عدم العنونة. وبهذا يختفي الجانب المؤلم من الذكرى الجحيمم. تبث لغة البعث في تحويل الحكاية إلى ملحق مضاف إلى الغسل والتبرج والزينة في شكل الاستمتاع بالحكي فتقول:
"و
هدم نهرها المليء
بعرائس السماء
وكيف اقتلعوا
ألوانها المتوهجة
حاصروا أحلامها المشردة
ومنعوا دموعها أن تذرف البكاء"
كل هذا تم تصويره من خلال حالة الخضوع النفسي لاستشعار اللقطة المعبرة عن المستقبل المتمنى. بتعميق التحليل أكثر يمكننا القول بأن مبدأ قلب التصوير المفضي إلى جعل الأرض مكان السماء والعكس صحيح هو المبدأ الذي انقلب بموجبه تحويل المشهد من صيغة التفاؤل إلى صيغة التشاؤم. صحيح أن الشاعرة تتحدث عن الجحيم ولكنها وضعته في صيغة نفسية متفائلة وهذا هو السبب السيكولوجي الذي أدى إلى جعل السماء مكان الأرض. وهو ما يمكن تسميته بالقلب اللفظي الموازي للقلب المعنوي. أو هو القلب المظهر الموازي للقلب المضمر. لنقارن بين القلب اللفظي والمعنوي في مقابل مظهر التفاؤل والتشاؤم. إن الأرض التي حلت محل السماء هي الأرض التي تقابل التشاؤم. وأن السماء التي حلت محل الأرض هي التي تقابل التفاؤل. وبما أن العروس قد صورتها في الأرض التي تمثل التشاؤم فإن ذلك يوازي أيضا طريقة انطلاق الشاعرة من مشهد التشاؤم إلى صيغة التفاؤل !. سنحاول قلبا معاكسا للنص بغية إنتاجه بطريقة مألوفة مفككين بعده الفني لنرى كيف ستبدو الصورة. لو افترضنا أن الأرض التي صورت فيها الشاعرة مشهد العروس غير خاضعة لمبدأ القلب الفني والسيكولوجي فسنجد أنفسنا أمام أرض مألوفة وسماء مألوفة. إذا كان الأمر كذلك فإن غزة لن تأخذ شكل العروس بل شكل الموءودة في رمضاء الجحيم الصهيوني. ليركز القارئ على هذه النقطة فهي تؤدي بنا إلى الدخول في إبراز آلية التصوير البلاغي البياني الذي تستخدمه الشاعرة سلمى في هذه القصيدة وبالتالي التعرف نوعا ما على أسلوبها الإنتاجي. إن العلة التي تحولت بموجبها السماء إلى الأرض هي التي مهدت لتعريس غزة عن طريق صياغة المشهد الحاضر المشؤم صياغة المستقبل المتفائل. ففي الوقت الذي تسجل سخرية من السماء، على المستوى البلاغي، نجد من الناحية النفسانية بأن المجيء بهذه السماء إلى مكان الأرض في الأسفل تم من أجل حسن التناغم مع المشهد الذي تحولت فيه غزة إلى عروس. أي إذا كان من المستحيل أن نذهب بغزة إلى قمة السماء (المستقبل المرجو) فلنأتي بهذه السماء نفسها إلى الأسفل (الحاضر البشع) لنعرس غزة فيها ! لاحظ أن المجيء بالسماء إلى مكان الأرض يساوي المجيء بالمستقبل المرجو لغزة إلى الحاضر المعيش الآن. وذلك من خلال الصياغة التفاؤلية التي تحدثت عنها أنفا. للمزيد من الاستغوار أقول إن العجز الطبيعي عن تحدي الحاضر البشع وتخطيه نحو المستقبل المتمنى هو الذي ترمز إليه الشاعرة بمشروع الإتيان بالسماء نزولا إلى مكان الأرض. ولهذا نجد الشاعرة تتجاوز الجانب المؤلم إلى الجانب المؤمل من الجحيم القائم عندما تتحدث عن الزينة والتبرج والغسل وقص الحكايات حتى وإن كانت تدور حول المأساة كما قلت سابقا. الآن بدأنا نلاحظ مظاهر ما سميته تلحيم المنقسم بشكل أوثق صلة بالبعد السيكولوجي للشاعرة على مستوى التعليل. فمن خلال ما سبق في هذه القصيدة نرى تلحيما بين منفصلين أو منقسمين وهو توحيد الشاعرة بين الأرض والسماء من جهة بحيث أصبح بإمكان كل واحدة منهما أن تلعب دور الأخرى. ومن جهة أخرى نرى توحيدا (تلحيما) بين المنفصل الزمني الكامن في توحيد المستقبل مع الحاضر. فالعة وراء ذلك هي أن المنفصل كلما تكرس انفصاله وانقسامه على مستوى المرجع (الواقع) يتم تلحيمه في قصيدة سلمى !!. إذن فهذا التلحيم، المتجلي في قيام أحد أطراف المنفصل المرجعي بلعب دور الطرف المضاد، يشير سيكولوجيا إلى التعبير عن انعدام البديل المتمثل في الشغور الذي تركه هذا المضاد على الساحة الملموسة نتيجة غيابه.
بعد ذلك تدخل الشاعرة في المرحلة المتعلقة بتغطية الحاضر والذي هو عبارة عن ذبذبة الإحساس بالألم وتقول من أجل الإشارة إلى حرق المرحلة:
"و................و.................و
والآن
ها أنك تكتبين بقلم الأحزان
بيان
نعيهم الأخير
وتقرئين على موتهم
فاتحة الكتاب"
إنه عقد قران بين صيغة التشاؤم والتفاؤل التي عودتني الشاعرة سلمى على سرعة التأرجح بينهما من خلال التذبذب الذي رأيناه في قصيدتها "شقائق القمر" بين المواسم على سبيل المثال. حتى تلك الواوات التي تفصل بينها النقاط في هذا المقطع تشير إلى الانتقال من مرحلة إلى أخرى. ولقد صرحت الشاعرة بعد ذلك بقولها " والآن" كأنها كانت على وعي تام بأن صيغة المشهد التفاؤلية، التي قامت بها من خلال المقطع السابق، كانت بعيدة عن "الآن" أي في المستقبل. إن رصد مبدأ تلحيم المنقسم في شعر سلمى يجعلنا قادرين على تفسير حتى سرعة تذبذبها بين صيغة وأخرى بغض النظر عن حمولات هذه الصيغ. ومن هنا يمكن القول بأن مبدأ توحيد المنقسم لدى الشاعرة يمكن تصفحه حتى في قصر المسافة النصية بين صيغة التفاؤل والتشاؤم نفسيهما. نعم، إن الشاعرة تشتغل هنا على نوع من التوحيد بين الإحساسين (التشاؤم والتفاؤل) إتماما لعكس الصورة المرجعية التي تفتقد لأحد الأطراف (وهو موضوع التفاؤل) مما أنتج شغورا (واقعيا) يستحق أن تملأه في قصيدتها (فنيا) كما سبق الحديث عن ذلك. وللمزيد من تأكيد هذا المبدأ ها هي الشاعرة تدخل مرحلة مضادة مباشرة بعد هذا المقطع فتقول