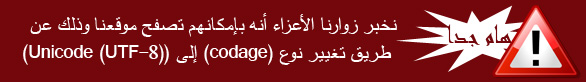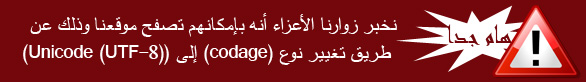أنيس الرافعي، قاص مغربي من مواليد الدارالبيضاء يشتغل على جماليات التجريب. عضو اتحاد كتاب المغرب. ترجمت نماذج من قصصه إلى اﻹسبانية والفرنسية والانجليزية والتركية والبرتغالية. من أعماله الفردية في جنس القصة القصيرة: فضائح فوق كل الشبهات/ 1999، أشياء تمر دون أن تحدث فعلاً / 2002، السيد ريباخا/2004، البرشمان/2006، علبة الباندورا/ 2007، ثقل الفراشة فوق سطح الجرس/2008، اعتقال الغابة في زجاجة/2009، وصدرت له مؤخرا عن دار فضاءات الأردنية مختارات قصصية تحت عنوان : "هذا الذي سيحدث فيما مضى". التقيناه فكان هذا الحوار:
تبدأ عندك المفارقة من العنوان، فمجموعاتك القصصية ونصوصك تحمل عناوين مركبة بأسلوب غير اعتيادي ولاواقعي، انطلاقا من هذا وتأسيسا عليه هل يمكن لك أن تحدثنا عن دور العنوان في أضموماتك القصصية وفي قصصك، هل هو مجرد عتبة للمرور إلى النص أم يدخل ضمن لعبة التجريب لديك أم شيئا آخر؟
باﻹضافة ﺇلى دور الثريا المعلقة في سقف العمل ﻹضاءة عتماته، أي وظيفة النص الموازي بوصفه عتبة. أعتبر العنوان- أيضا - استراتيجية تجريبية بامتياز. أقصد، أنه يضطلع بدور اليافطة، التي تنضد وتؤطر مضان المشغل المفتوح المرتبط بكل مشروع على صعيد الموضوع والتشخيص واللغة والتخييل والتقنية واﻷسلوب والمعمار. وعليه، ﻓﺈن العصب المركزي ﻷي كتاب قصصي يكون متمركزا في عنوانه، واختيار هذا اﻷخير لايخضع على اﻹطلاق للصدفة أواﻹعتباط، بل هو شمل خيمة جامعة أو جغرافيا افتراضية موحدة، توفر التكامل أو التقابل سواء بين الجزء والكل أم بين القطع والمجموع.
نلاحظ في قصصك ذلك الطابع الكافكاوي الذي يتحول فيه السرد تدريجيا من الحلم إلى الكابوس، مامدى تأثرك بكافكا (رغم تباعد المجال وتقاطعه بين الرواية والقصة) مع العلم أن الكثيرين يعتبرون كافكا عصيا على التقليد؟
كان فريدريك نيتشه كثيرا مايردد «أننا لانصيخ السمع سوى ﺇلى اﻷسئلة التي نحن قادرون على العثور على ﺇجابة لها». وبما أن الرد لن يسعفني، دعني أقل لك بأننا كلنا ياعزيزي، شئنا أم أبينا، كافكاويون. أعني، جميع الكتاب الطبيعيين. كما يمكن أن نكون كافكاويين حتى دون أن نقرأ سطرا واحدا لكافكا في حياتنا. الكافكاوية وجدت قبل كافكا، فقط لم يكن لها ﺇسم يدل عليها. ستحمل هذا اﻹسم فيمابعد عندما عثر عليها علماء ﭐثار اﻷدب بين تلافيف المخطوطات التي قيل – حسب رواية ماكس برود- بأنها تعود لشخص يدعى فرانز، لا أحد يعلم ﺇن كان شخصا حقيقيا من لحم ودم، أو متخيلا، أم فحسب من وحي خيال ماكس برود. ماكس ذاته الذي قد يكون مجرد ﺇسم مستعار أو بديل من بدلاء فرانز. الكافكاوية، قبل كافكا، كانت موزعة بين بطون ما لايحصى من الكتب. في هذا شيء من فقدان اﻷمل، وفي ذاك شيء من العبث. بعض من الريبية واللاجدوى هنا، وبعض من السوداوية واﻹنمساخ هناك. وبعد كافكا، أضحت مجتمعة برمتها في كتاب واحد...ها أنت ترى كم أنا ﻤتأثر بكافكا حد العظم!.
قرأت لك بعض القصص المتفرقة قاربت فيها تيمة الموت بأسلوب حداثي ومفارق للواقع، ساعتها تبادر إلى ذهني أن لديك مشروع اشتغال على تيمة محددة، هل صدق حدسي أم أنها كانت مجرد نزوة قصصية استطعت فيها اللعب على أفق التلقي لدي، كقارئ مفترض؟
عادة، في غمرة الحياة واصطخابها، لانخاف من الموت بما فيه الكفاية. ﺇذ لم نمت من قبل ولاحتى مرة واحدة. وحده الكاتب أو الفنان من يستشعر هذا الخوف بحدة ، بأنه كلما أقدم على الخلق أحس بأنه مات قليلا. لذلك قيل بأن اﻹبداع طريقة مقنعة لمقاومة الموت. في اﻵونة اﻷخيرة، لا أخفيك بأنني أحلم كل ليلة بشكل متواصل أنني أقف على جرف عال جدا، وفي قعر الوادي ثمة شخص يشبهني بحذافيري. شخص ميت يناديني بلا توقف. عندها، وطدت عزم السرد والهمة على أن تكون مجموعتي القادمة - وأتمنى أن لاتكون اﻷخيرة - عن هذا الموضوع الجليل المسمى موتا بكل أنواعه المادية والرمزية، عل ذاك الشخص الذي يشبهني يتوقف ﺇلى حين عن مناداتي.
ماذا يشكل بالنسبة إليك المتلقي هل مجرد قارئ عابر أم قارئا عالما ومستعينا بعدة نقدية تمكنه من تفكيك «رسائلك» وإعادة تركيبها، وبالتالي هل تعتبر نفسك كاتبا نخبويا؟
طبعا، القارىء يدخل في ﺇعتباري، ﻷنني لا أكتب لنفسي أو ﻟﻸشباح.غير أني أراهن على قارىء من طرازي. قارىء نخبوي يحب النصوص اﻷرستقراطية- والتوصيف هنا مفرغ من أية حمولة إديولوجية أو طبقية – وله القدرة والكفاية لتلقي وتذوق والمنافحة عن شكل مغاير من اﻷدب. أما فيما يتعلق بي، فخياري الجمالي واضح ،واصطفافي التجريبي لارجعة فيه. عندما ﺴﺄصل ﺇلى طريق مقطوعة أو ﺴﺄصطدم بالجدار، ﺴﺄتوقف وأعتزل الكتابة. لايهمني اﻹستهجان ولا الممانعة صريحين أو مبطنين. لاتهمني ردة التجريبيين وﺇعلانهم للتوبة. فالعقوق مذهبي وشرعتي. لاتعنيني اﻷصولية القصصية التي تمجد القاعدة والحس المشترك والنموذج وتكرار المتماثل. فقد كنت على الدوام أقلية وهامشا. «وحدي في الغابة، والغابة أنا» كما قال الجميل سركون بولص. لايعنيني الحرس العتيق أو الجديد لمعبد القصة. لايعنيني الذرائعيون الذين يدعون الجميع للامتثال لمقتضيات دفتر تحملات الجنس اﻷدبي. ولايعنيني متممو مكارم أخلاق القصص ومقاصدها ممن يرفضون كسر قيود الوعي السردي السائد، وﺇحلال ذوق بديل للذوق الجماعي المهيمن. ما يهمني ويعنيني، هو ﺇعادة ﺇعمار اﻷراضي الفارغة للقصة.
رأى بعض النقاد أنك تستلهم الفن السابع في قصصك وأن هذه الأخيرة تحتوي عل مفردات السرد السينمائي، هل تتفق مع هذا التحليل؟
يدخل توظيف مفردات العالم السينمائي ضمن تصوري لتجربة الحدود الكيميائية للاستعمالات القصصية. ﺇذ أهتم بكيفية انتظام وتراصف وتذرير وتضفير المستويات المرحلة من هذا السجل التعبيري مع مستويات السرد القصصي، أي علاقات اﻹخضاع التي تحدث بين المستوى اﻷصلي، القص/الداخل حكائي، والمستوى المستجلب، القص/التحت حكائي. وهنا أنبه ﺇلى اﻹلزامية التي تقع على عاتق القاص – أثناء المعالجة الحرفية - في ﺇعمال مبدأ الملاءمة بين مقادير القصصية ومقادير اﻹستقطابات المستقدمة من الفن السابع ، مع مراعاة اﻹختلافات من حيث طرق العرض ووسائط التمرير. مهارة قيادة حصانين بيد واحدة ﺇذا شئنا استعمال اﻹستعارة للتعبير عن هذه الملاءمة الملمع ﺇليها. ففي تقديري الشخصي المتواضع ومن خلال فقه الشعريات التماسية الذي استطعت أن ألمسه من خلال الممارسة، اﻹستقطاب من السينما ليس حجابا للقصصية أو مبررا لنسف اﻷثر القصصي ودفعه ﻷن يصير على هامش السرد، ﻷ نه عندما يتم توجيه دفة الجنس القصصي نحو تلك المنطقة المستنقعية الملتبسة التي تتلوث فيها المياه اﻹقليمية للسرد بالمياه الغريبة لفن ﭐخر مثل السينما، يجب مراعاة أن لاتخرب أمواج التفاعل الجسر الفاصل بين الصميميات النوعية للجنس القصصي والقيمة اﻹيحائية فحسب لهذا اﻹستقطاب. صحيح، أن القصة حمالة أوجه. بلا خصال. منذورة على الدوام للتهجين والتخصيب. للخلاسية والنومادية. للاستوائية والحربائية، لكنها ليست جنسا خنثويا أو قصة اللانوع. ﺇذ أن مناط تجربة الحدود الكيميائية ومقصدها الرئيس هو ﺇعادة النظر في دعائم تثبيت الجنس اﻷدبي. ﺇحداث تعديلات وراثية على جينومه. تحسين جودة نسله. خدمة تطوره السلالي. الرفع من الكفاءة التقنوية لمنتج القصص وتمهيره على اﻹشتغال الموضعي على اﻷجزاء الصغرى والدقيقة والرقيقة القشرة للسرد، وليس قيادته خارج الجنس اﻷدبي لينتج جنسا ثالثا، لاهو بالقصة ولاهو بالسينما.
هل تعتبر أن تجربتك القصصية تشكل نوعا من الاستمرارية في المشهد القصصي المغربي أم على العكس أنها قطيعة من داخل هذا المشهد وانتقال إلى آفاق قصصية أخرى لم تطرقها القصة المغربية من قبل؟
أن أدعي بهتانا أنني أشكل قطيعة. بكل صراحة، كلام من هذا القبيل مبالغ فيه. وقاحة حتى، ولا أرضاه لنفسي. ﻓﺄنا كما قال شاعرنا العظيم محمد بنطلحة «ﺇسمي: لا أحد». كما أنه لايستند ﺇلى أي أساس نقدي صلب. تقول حكمة ﺇيرانية بليغة «لاجدوى من اﻷيام الغائمة، مادمت ستفقد الظلال التي ترافقك دائما، تارة من اﻷمام، تارة من الجانب، وتارة أخرى من الخلف».ترى، ماذا سيكون مصيري لو فقدت ظلالي؟.. ما أنا يا صاح سوى نقطة ماء في البحر المتلاطم للقصة المغربية الذي خاض أمواجه من سبقوني، وسيخوضه من ﺴيأتون بعدي. هذه التخريجات لاتعدو أن تكون مجرد أوهام. مجرد أمواس قاتلة في خاصرة الكتابة. مجرد أعطاب للتغرير بالموهبة. مجرد قرع مجاني لطبول النرجسية قدام أرض خالية. يقول خوليو كورتاثار «كاتب القصة يعرف أن الزمن ليس صديقا له»، وعلى هدي هذه الحقيقة المفجعة، أنا مطالب بأن أجتهد ﻷكتب أحسن في كل مرة مادام الزمن ليس في صالحي. أن أعثر على المناطق والجهات غير المتوقعة للكتابة. أن أعمل بدقة وصبر الساعاتي وصائغ الماس وحيوانات القندس. أن أفاجىء نفسي في اللحظة التي لاتتوقع مني نفسي أن أفاجئها. وهذا هو اﻷهم، أما ماعداه فبلا قيمة.
ماذا تشكل بالنسبة لك تجربة القص في أمريكا اللاتينية وبالضبط اسم ك مونتيروسو؟
القاص مثل ﭐلة شرهة لسلوجة الذرة. يلتهم القصص بمختلف تلاوينها ومرجعياتها من الفتحة اﻷمامية، ثم يطرحها من الفتحة الخلفية ليحصل على مواد سردية صالحة لبناء صرح قصصه الخاصة.القاص البارع مثل الميكانيكي الذي يزيف تركيبة وأرقام محرك سيارتك المسروقة، ثم يعيد بيعها لك عبر وسيط. تشكره، وعندما يخبرونك بالحقيقة، تقسم بأغلظ اﻷيمان أنهم على خطل ﻷنهم لايعرفون سيارتك جيدا أنت الذي سقتها لمدة عقدين من الزمن.يقول فيليب روث «الكاتب الجيد يسرق، والكاتب الرديء يقلد»... أمريكا اللاتينية هي مسقط رأس قصصي. ولقد كتبت ذات شهادة بأنه فاتني أن أكون أرجنتينيا. صدقني، في أعماقي أنا أرجنتيني حقيقي، سقطت فحسب عن طريق الخطﺄ المحض في هذه الجغرافيا البعيدة عن موطني ﻷصير مغربيا!... لاداعي ﻟﻸسف، فكل بلاد الله أوطاني...لاتربطني علاقة وطيدة بأغوسطو مونطروسو، ﺇذ اطلعت عليه متأخرا نوعا ما، فلم أستطع كما جاء في عنوان ﺇحدى قصصه الفاتنة أن كون «تلك الصاعقة التي سقطت بنفس المكان مرتين»، لكن بالمقابل تربطني أواصر روحية أعمق بأعمال خوليو كورتاثار، وروبرطو بولانيو، وخوصي دونوسو، وأضولفو بيوي كاساريس، وخوان رولفو، وهوراثيو كيروغا، وبرخيليو بينيرا، وفلسبريطو هرنانديت... تقريبا مع كل الذين يسيرون لوحدهم في الليل الموحش ﻟﻸدب، ويصيحون: لماذا «لا أحد يضيء المصابيح»؟.
عرف المشهد القصصي في المغرب طفرة كمية مع بداية الألفية الثانية ومدا أخذ يخبو تدريجيا لكي لا تبقى منه على السطح سوى أسماء معدودة ربما أنت أهم اسم فيها، كيف تقيم هذه الطفرة التي تميزت بالتجريب في طرق سردها وبكثرة بياناتها؟
على الرغم من كوني لست من أنصار هذه التحقيبات الجيلية، ﻓﺈن المحطة التسعينية مرحلة مهمة في مسيرة القصة المغربية بأنها بأن المحطات اﻷخرى، دون أن تزيد عنها أهمية أو تقل. مهمة بكل اﻷسماء اﻹبداعية التي شاركت في رسم ملامحها.مهمة ببياناتها الصاخبة ،وملتقياتها الهامشية، وﺇصداراتها الوفيرة، وﺇطاراتها التي مازالت قيد النبض أو تلك التي لفظت أنفاسها. بل، مهمة حتى بصراعاتها وحروبها الصغيرة التي تبدو مع تصرم اﻷيام أنها كانت ذات طابع صبياني وغير مبرر، لكنها صبيانية ولاتبريرية رائعة وضرورية للنضج حتى يشق كل واحد جدوله الصغير الذي يعتقد أنه سيفضي به ﺇلى النهر. النقطة الوحيدة السوداء في هذا المسار – ﺇذا سمحت لي أن أتحدث عن نفسي – هي أنني فقدت صداقات كثيرة كان من الممكن أن تكون كبيرة ومثرية. وهذا مؤلم من الناحية اﻹنسانية .يقول خوصي ساراماغو «عندما تنتهي الصداقة، تنتهي أيضا الصور». أنا تقريبا، اﻵن، بلا صور.وأعتقد، بأن هذا اﻷمر لا يسري علي فحسب، بل هو ظاهرة عامة عند هذا الجيل. نحن جيل بلارفاق سلاح، ﻷ ننا صفينا بعضنا البعض أثناء رحلة الطريق للوصول ﺇلى ﺇلدورادو القصة، وهذا كلام صريح، وأتحمل مسؤوليتي كاملة عنه .
باعتبارك ربما القاص المغربي الوحيد من بين جيلك الذي استطاع فرض اسمه في المشرق العربي، هل تظن أن المشارقة مازالوا ينظرون إلى المغرب باعتباره بلد النقد فيما ظل الإبداع حكرا عليهم؟
هذا كلام غير صحيح بالمرة، لست الوحيد باﻟتأكيد، بل ﺇن أهل الحل والعقد القصصين في المشرق يعرفون الكثير من اﻷسماء روادا ومحدثين، وعلى ﺇطلاع نسبي على منجزهم. الملتقيات العربية والشبكة العنكبوتية سهلا الكثير من اﻷشياء وكسرا حواجز كانت متأبية. المشكلة أن المشارقة – باستثناء المخلصين لعقيدة القصة – لم يعد يستهويهم هذا الجنس اﻷدبي. بل، هناك من أعلن موته. ثمة نزوح جماعي صوب الرواية ﻷنها أكثر ﺇغراء على صعيد التداول والتحفيز والترجمة. وكما ينظر المهاجر الذي ﺇغتنى في المهجر ﺇلى ﺇبن البلد الذي بقي يعيش شظف العيش على دخله المحدود، هكذا ينظرون لمن يكتب القصة. الفورة القصصية التي يعرفها المغرب تدهشهم بديناميتها وسمتها الخاص في الكتابة ﺇبداعا ونقدا. لدينا كاتبات وكتاب مهمون للقصة. لدينا نقاد بارعون. لدينا مدرسة قصصية مغربية برصيد محترم، يبقى علينا فحسب أن نعرف كيف نروج للتجربة المغربية في المجال. أن ﻴﺄتي اﻵخرون ﺇلينا لا أن نذهب لهم. أن نصبح محجا عوض أن نكون حجيجا.