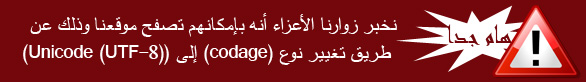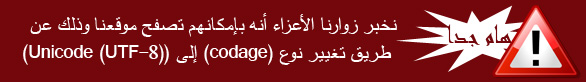يعتبر الجيلالي فرحاتي من بين أهم المخرجين المغاربة والعرب. ولد سنة 1948 وتابع دراسته بباريس في الفنون الدرامية والإخراج، وقضى سنتين بنفس المدينة حيث شارك في أنشطة المسرح الدولي بباريس حيث أخرج عدة مسرحيات ومثل فيها، وبعد تخرجه عام 1973 أنجز عدة أفلام تسجيلية أهمها «كاروم» و«صباح الخير سيدتي» سنة 1974، وبعد عودته إلى المغرب أخرج سنة 1977 فيلمه الروائي الطويل الأول «جرح في الحائط» الذي شارك به في مهرجان «كان» ضمن زاوية «أسبوع النقد» ليأسس بعد ذلك شركة إنتاج باسم «هرقلس فيلم» سنة 1981 ويخرج في نفس السنة فيلم «عرائس من قصب» الذي اختير أيضا للمشاركة في المهرجان نفسه ضمن فقرة «أسبوعي المخرجين». ولم يظهر فيلمه الطويل الثالث «شاطئ الأطفال الضائعين» الذي نال عنه حفاوة نقدية، إلا سنة 1991 والذي اختير بدوره للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية الشهير، ليحوز بعد ذلك وفي نفس السنة على الجائزة الأولى وجائزة الصحافة إضافة إلى جائزة أفضل تمثيل نسوي لأخته سعاد فرحاتي في المهرجان الوطني الثالث للفيلم بمكناس. أما فيلمه الرابع «خيول الحظ» الذي ظهرسنة 1995 فقد نال عنه الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة (1995). وأنجز سنة 2000 فيلم «ضفائر» الذي أحرز عدة جوائز بالمهرجان الوطني السادس للفيلم ومهرجان تطوان للسينما المتوسطية ومهرجان قرطاج السينمائي. وأخرج سنة 2005 فيلم «الذاكرة المعتقلة» الذي لم يشد عن القاعدة وفاز بالجائزة الكبرى في مهرجان تطوان للسينما المتوسطية وجائزة السيناريو بمهرجان القاهرة السينمائي، لينجز هذه السنة (2010) فيلم «عند الفجر»، الذي شكل ضمن اهتمامنا بتجربة هذا المخرج، محور الحوار التالي:

- نجد في فيلمك الأخير «عند الفجر» مقاربة خاصة وحنينا للمسرح الذي رجعت إليه مؤخرا كمخرج هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الجانب في الفيلم؟
-أخرجت فيلم «عند الفجر» تحية للمسرح في المغرب ولنسائه ورجاله، وطرحت فيه أيضا تلك المتغيرات في المبادئ والإديولوجيات، إذ أن مضمون العمل الإبداعي أصبح يخيف بعض المسؤولين، ولم تعد هناك جرأة في التعامل مع الديموقراطية والإبداع كمجال للحرية. أردت طرح هذه الأفكار في الفيلم ولكني لم أرد أن أقول كل شيء، وتركت بياضا ومجالا للمشاهد كي يكمل من عنده.
-ارتباطا بهذا، كيف تنظر إلى العلاقة بين المسرح والسينما؟
- يصعب علي أن أفرق بينهما لأني إبن المسرح والسينما معا، فأنا أخلق دائما في أفلامي بعض الفضاءات المسرحية، وأشتغل في أفلامي على أداء الممثلين، إذ أنني لا أدع الممثل إلا حينما أتيقن أنه قد أخذ طريقه الصحيح في أداء الشخصية، وهذا مايقرب كثيرا السينما عندي بالمسرح. وأقول دائما أن من يرتاد المسرح ويشاهد مسرحية تكون لديه رؤية سينمائية، إذ يقوم بتقطيع لقطاته الخاصة التي يُكَون منها مشاهد «من إخراجه»، فمن لقطة بعيدة إلى أخرى قريبة وأخرى متوسطة، ثم لقطة أمريكية، حتى أنه في بعض الأحيان يحيد ببصره عن الخشبة محولا عينيه إلى الجمهور ليشاهد ما يحدث هناك، وهكذا يصنع فيلمه الخاص به من خلال عملية المشاهدة هاته.
- لكن كما هناك أمور يتقاطع فيها المسرح بالسينما هناك أيضا أخرى يفترق فيها أبو الفنون عن الفن السابع، فطريقة التمثيل في المسرح على سبيل المثال ليست هي نفسها طريقة التمثيل في السينما، وباعتبارك ممثلا ومخرجا في نفس الآن ماهي الأدوات التي تستخدمها في إدارة الممثل؟
- العلاقة بين الممثل والمخرج يجب أن تكون مبنية على الثقة التامة، وعلى الصراحة، لأنه إن لم يكن هناك تبادل للأفكار ولم ينشأ بينهما تواطؤ إيجابي لايمكن أن ينجح العمل أو ينتج عن لقائهما أي شيء ذو قيمة تذكر، وأنا أومن أن الممثل كلما أحس أنك لا تسيره إلا وأعطى أحسن ما لديه، لأن الممثل يكون داخل «البلاطو» مثل طفل، ويجب على المخرج أن يحرص على ألا يزعجه أي شيء أثناء التصوير. أنا طبعا أتكلم مع الممثل كثيرا عن السيناريو وعن الشخصية التي يؤديها، وفي نفس الوقت أنصت لاقتراحاته قبل أن أوجهه، ولدي قناعة وقاعدة أعتبرها مقدسة في السينما وهي أن الممثل الذي لا يستطيع أن يديرني لن أستطيع بدوري أن أديره...
- طبعا، فنتائج الاشتغال على أداء الممثلين تظهر في أفلامك، لكن ألا يرجع الفضل في ذلك لكونك ممثلا في الأصل قبل أن تكون مخرجا؟
- لقد تكونت كممثل وقمت بعد ذلك بالإخراج المسرحي الذي قادني إلى الإخراج السينمائي، وهذا ساعدني لمعرفة ماذا تعني كلمة ممثل، فحينما يكون الممثل منزعجا أثناء التصوير، أعلم ما الذي أزعجه وأجد له حلا، طبعا هناك مخرجون ليسوا ممثلين لكن لديهم قدرة ودراية نفسية تمكنهم من تجاوز مثل هذه المشاكل، إذ أنهم يستطيعون استكناه إحساس الممثل ومعرفة نقط ضعفه، وهذه هي الأمور التي على المخرج السينمائي أن ينتبه إليها، وإلا فلا يمكنه أن يتعامل ويدير الممثل بكيفية جيدة.
- نجد في فيلمك «عند الفجر» تلك الجماليات في الصورة التي ربما افتقدناها في بعض أفلامك الأخيرة، خصوصا تلك التي تلت «شاطئ الأطفال الضائعين».. هل هذا رجوع إلى أسلوبك القديم وحنين إليه أم ماذا؟
- السينما هي أولا وقبل كل شيء لغة الصورة بكل مكوناتها من ألوان وإنارة.. الفجر له لون معين والليل لون معين.. وأنا دائما أشتغل على الإطار بكيفية مركبة، لأن الإطار فيه عمق، وليس مسطحا، وأنا بالتالي أعتبر ماهو جمالي أساسيا في السينما، فحتى في الأبيض والأسود فقط، تظل الألوان حاضرة، والسينما هي كل لا يتجزأ إذ لا يمكن الحديث عن السينما كحكي فقط، لأن هذا الأخير أيضا في السينما له قواعده، فكيف تحكي، وظيفة المونطاج، إيقاع الفيلم ووظيفة الزمن في الفيلم كل هذا له دوره.. أنا أشتغل على الملابس وعلى الألوان وعلى الإطار، والإطار داخل الإطار، وعلى كل ما يمكن أن يخدم رؤيتي الجمالية للفيلم والسينما عموما.

- لكن البعض يذهب إلى أن سينما المؤثرات الخاصة في طريقها إلى القضاء على سينما المؤلف التي تعتمد على الصورة الغير معدلة إلكترونيا والمعتمدة فقط على اجتهاد المخرج؟
- نحن بعيدون عن هذا النقاش، ومن الخطر الذهاب مع هذا الطرح، فَالْنَمْضِ في تجريب وصنع السينما الكلاسيكية التي نتقنها، تلك التي نحكي فيها قصة دون أن نحتاج إلى مؤثرات خاصة وخدع بصرية تعتمد على الكومبيوتر.. لكن مع الأسف الذي حدث هو أنه عندما وصلت السينما باجتهاد مخرجين كبار إلى تكريس التعبير بالصورة الخالصة وكنوع من العودة إلى السينما الصامتة وتكريم لها، وجدنا أنفسنا في عصر الكمبيوتر والخدع السينمائية.. لكن الذي أخاف منه هو أن تنخرط الأجيال القادمة من المخرجين المغاربة في نوع من التقليد الأعمى لهذه الموجة من الأفلام المعتمدة - كليا أو بطريقة شبه كلية - على الصورة المعدلة إلكترونيا، إذ أني شاهدت أفلاما قصيرة مغربية لا تقول أي شيء ولا يهم صاحبها سوى قول أنه يعرف أن يستخدم المؤثرات الخاصة، رغم أن الفضل يرجع إلى الكومبيوتر، الذي يمكن لأي كان أن يستخدمه ويصنع به مثل هذه الأشياء. الأجيال الجديدة تنقصها الثقافة ليس السينمائية فقط، بل الثقافة عامة، إذ تجد لديهم ألف «دي في دي» في المنزل ولا تجدهم قرؤوا ولا حتى كتابا واحدا.
- في نفس السياق هل تظن أنه مازال لسينما المؤلف، التي تعتبر أحد روادها في المغرب والعالم العربي مستقبل، أم أن جمهورها قد أخذ ينفض عنها ويتناقص؟
- أظن أننا وقعنا في فخ التمييز بين سينما يطلق عليها سينما المؤلف وأخرى تجارية، الأمر الذي أصبح بالنسبة إلينا سيفا ذا حدين، إذ أن الموزع أصبح يتذرع بهذا لكي يقول «فيلمك لن يلاقي رواجا جماهيريا»، لما كنا في بدايات السينما المغربية، كنا نصنع أفلاما لايراها الجمهور المغربي الذي كان مفروض عليه مشاهدة الأفلام الهندية والأمريكية. ونحن الآن في مرحلة يجب أن تعرض فيها في دور العرض كل الأفلام المغربية، وعلى المشاهد أن يختار ويحكم دون وصاية الموزع أو أي كان. أن تعرض تلك التي تشبه الأكلة السريعة أو الأخرى التي تدفعه للتفكير وتحترم ذكاءه، رغم أن الجمهور المغربي مازال لا يتجاوب كثيرا مع هذا النوع الأخير من الأفلام، لأنه يرفض الفيلم الذي يظل يؤرقه بعد ثلاثة أيام من مشاهدته له...
- لكن يبدو أنك بعد «شاطئ الأطفال الضائعين» وتزامنا مع المرحلة التي «تصالح» فيها الجمهور المغربي مع السينما المغربية، أصبحت تعيش نوعا من المعاناة في محاولة منك الحفاظ على أسلوبك، وأن تكون أفلامك جماهيرية في نفس الوقت.
- الأمر له علاقة بحياتي الشخصية وفقدان أناس أعزاء علي، إذ أنني طرحت بعدها (الفترة التي تلت إخراجي لـ«شاطئ الأطفال الضائعين» 1991 إلى 1994) أسئلة على نفسي فيما يتعلق بعلاقتي بالسينما ووعيي بها وعلاقتي بالجمهور وبعدة أمور أخرى، لأن صناعة فيلم تجاري هي أسهل الأمور وأبسطها، وفي نفس الوقت رغم أني أرغب أن يشاهد فيلمي أكبر عدد ممكن من المشاهدين فأنا لا أريد للذين يتتبعون تجربتي ولمن هم قريبون مني وأحب أن أتناقش معهم حول السينما وماهيتها، أن يحسوا بخيبة أمل حينما يشاهدون أفلامي، وهكذا يظل دائما لدي ذلك الاحترام للسينما كفن، واحترام للجمهور الذي يأتي ليرى أفلامي. طبعا يجب أن يظل الفيلم التجاري، لكن ليس إلى درجة الاستهانة بذكاء المشاهد، الذي يدخل في بعض الأحيان قاعة العرض ويشاهد فيلما وحينما يخرج يقول أي فيلم هذا؟! وفي حالات أخرى قد يدخل فيلما من عينة «أفلام المؤلف»، ولما ينتهي الفيلم يردد خطابا غريبا فيه ماهو إيجابي وماهو سلبي في نفس الوقت، قائلا: «إنه فيلم في المستوى، لكنه مصنوع لفئة أخرى وليس لي..» وكأن المشاهد هنا رغم أنه فهم الفيلم يستهين بذكائه ويظن أن مستوى الفيلم أكبر منه..
مع الفيلم التجاري المليء بالحركة والسريع الإيقاع، يتلقى المشاهد بكيفية سلبية ولا يكون متفاعلا مع الفيلم بعقله وذكائه، بل قد يفقد إحساسه بالزمن وهو يشاهد هذه النوعية، أما مع فيلم المؤلف فيحس بمرور الزمن الذي يبدو له بطيئا في الكثير من الأحيان رغم أنه ليس كذلك.
- كل السينمات التي وصلت إلى مرحلة الصناعة، تعاملت مع الأدب (الرواية والقصة)، لكننا نلاحظ نوعا من النفور الغير مبرر بين السينما المغربية والأدب المغربي، إلى ماذا ترد هذا الخصام، وهل لا تفكر في اقتباس رواية أو قصة مغربية للسينما؟
- هناك روايات لا يمكن نقلها للسينما وأغلب الأدب المغربي من هذه النوعية، فأنا مثلا كنت أريد اقتباس رواية «بيضة الديك» للكاتب الراحل محمد زفزاف للسينما، لكني وجدت أنها لا تحتوي «حدوثة» ولكنها عالم مغلق وقائم بذاته وغير مبني على أحداث ووقائع وصور ملموسة، وهي مثل «زمن الأخطاء» لمحمد شكري وليست مثل «الخبز الحافي» مثلا التي يمكن معالجتها سينمائيا. المؤلفون المغاربة لديهم أسلوب متميز وقدرة على خلق وصنع عوالم خاصة بهم لكن أعمالهم ينقصها الحكي الذي بدونه لا يمكن صنع فيلم سينمائي. ورغم ذلك فهناك أفلام عديدة مغربية مأخوذة عن روايات، هناك «جارات أبي موسى» لمحمد عبد الرحمان التازي و«الغرفة السوداء» لحسن بن جلون و«جوهرة بنت الحبس» لسعد الشرايبي و«عود الورد» للحسن زينون...